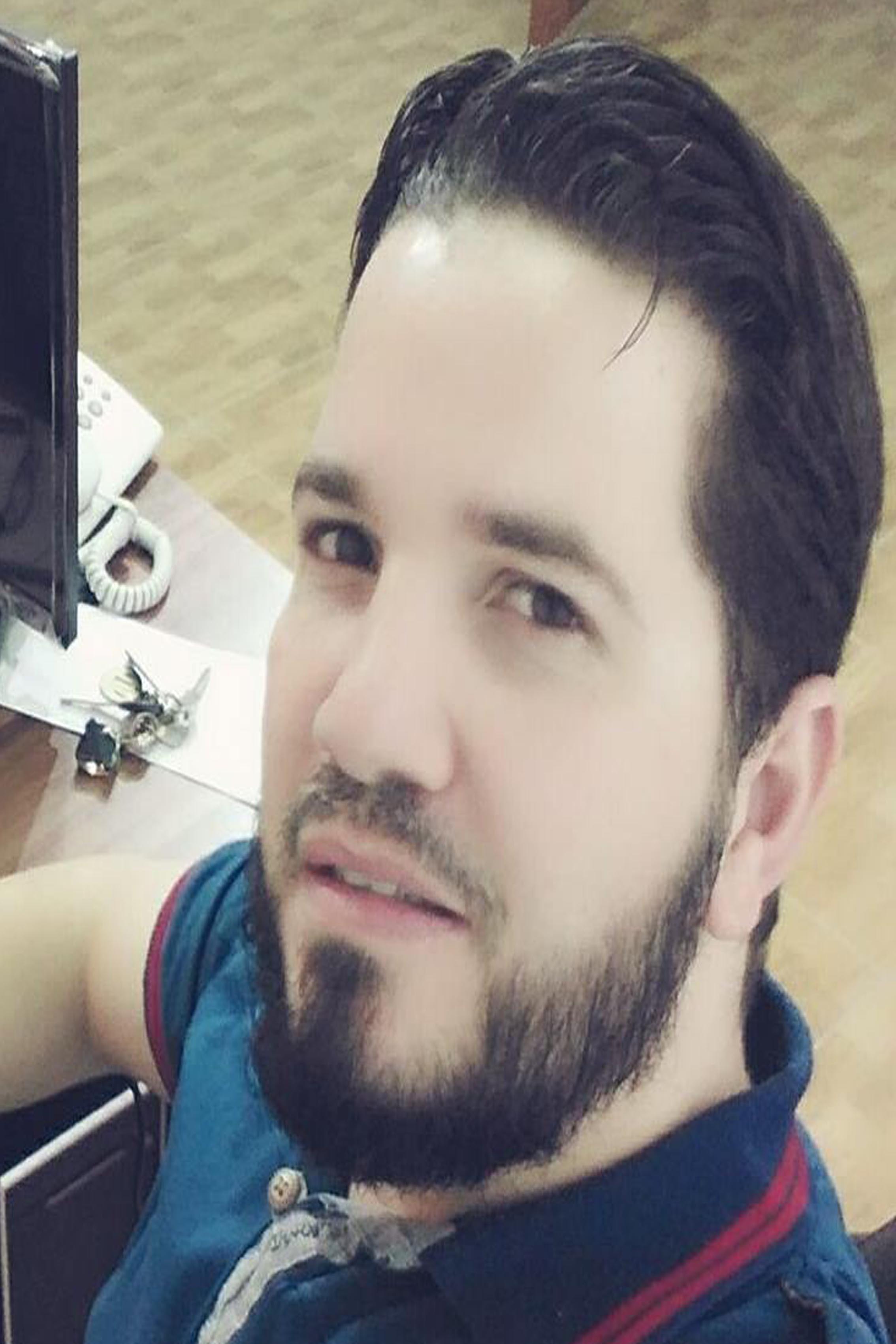 | الصحافة والأدببشير بالراس علي | مقالةتاريخ النشر: 2025/12/25
اقرأ للكاتب |
حين دخلتُ عالم الصحافة قبل بضعة أعوام، دخلته وأنا أحسب أن اللغة ستربحني كما أربحها، وأن بياني سيزداد صلابة واتساعا كلما أكثرتُ منه استعمالا!
كنت أظنّ أن القلم إذا أُكره على العمل كلَّ يومٍ ازداد طواعية، وأن العقل إذا عوّدته التحليل ازداد قدرة على الخَلق، وأن الصحافة بما تفرضه من ضبط ومهارة ستكون بابا آخر إلى الإتقان.!..
غير أن الأيام مضت، وتراكم الخبر على الخبر، والتحليل على التحليل، حتى وجدتني أكتب أكثر ويستحسن المديرون أدائي (أدعو أن يكون مديري الحالي نائما حتى لا يقول: نا؟! "بصوت الهمندعي"، لكني أفتقد النبرة التي كنت أعرفها في نفسي!.. ولم يحدث ذلك فجأة، بل خفوتا بطيئا..
كنت أظن - وربما كثيرون مثلي - أن الصحافة، بما تمنحه من تمرينٍ يومي على اللغة، وصقلٍ دائم للعبارة، وضبط صارم للمعنى، لا بدّ أن تكون سلّما يرقّيك نحو الإتقان الأدبي، وأن من طال عهده بها ازداد بيانُه صفاءً، وأسلوبُه رسوخًا، وقدرتُه على التعبير إحكامًا..! وهذا الظنّ صحيح في وجهٍ منه، غير أنه ناقص في وجهٍ آخر، لا يظهر إلا لمن ذاق الأمرين معا.. الصحافة والأدب..
بُحت لبعضهم بما أجد، وصرت أسأل لماذا تراجعتُ وأين ما كنت أكتب ويستجيده معلمي -الذي أثق في رأيه-، وبعض أصحابي المصطفَين - وأزعم أنهم ما كانوا يوافقونني تملقا أو نفاقا، ولا تساهلا أو مراعاة، فأنا أميز بين المجامل والصادق - وفكرت أن أعتزل الأولى لأعود للثانية قبل أن يسلُبها الإهمال والترك! ثم بدا لي - مع الوقت - أمر مهم!
بدا لي أن الصحافة تهذّب البيان، لكنها تهذّبه تهذيب الوظيفة لا تهذيب التجلّي، وتعلّمك أن تقول ما ينبغي قوله، لا ما تريد قوله، وأن تختصر الفكرة حتى تبلغ الخبر، لا أن تُقيم معها طويلا حتى تفيض دلالتها.. الصحافة تدرّبك على السرعة والانتباه ودقّة المعلومة، وتُعوّدك مراعاة القارئ العجول، وتدفعك من حيث لا تشعر إلى أن تضع نفسك خلف النص لا في قلبه! وهذا كلّه فضلٌ لا يُنكر، لكنه فضلٌ موجَّه!..
ومع طول الاشتغال بهذا النمط من البيان، يبدأ العقل في التحوّل دون أن ينتبه صاحبه؛ فيتقدّم عقل التحليل على عقل التخليق، وتغلب اللغة الوظيفية على اللغة الوجدانية، وتصبح العبارة وسيلة محضة!.. وحينئذ لا تموت ملكة الإبداع، لكنها تنسحب إلى الخلف، وتترك الصدارة لملكة أخرى أصلح للمهنة، وإن كانت أبعد عن الروح..
من هنا تولّد من قبل ذلك الإحساس المربك الذي يعتري الصحفي الأديب أو متذوق الأدب مثلي ممّن يحاول أن يصل؛ فيشعر بأن قدرته على التعبير الحرّ قد خفَتَت، وأن نفَسه الأدبي لم يعد يطاوعه كما كان، وأن العبارة التي كانت تنساب قد صارت تتحفّظ، وأن الأسلوب الذي كان يفيض صار يقتصد، فيحسب أن في الأمر تراجعا أو عجزا طارئا، والحقيقة غير ذلك.
لكن التأمل قادني إلى أن ما حدث ليس فقدانا للملكة، بل تغيّر في موضع استخدامها، فالصحافة تطلب منك أن تُطفئ ذاتك قليلا لتنقل الواقع في صورة مباشرة، وأن تُمسك عن الزخرفة لتُسرع إلى الخبر، وأن تُغلّب الوضوح على الإيحاء، والدقّة على الدهشة، ومع كثرة هذا الإطفاء المؤقت للنَفَس الأدبي تخفت حرارة الأسلوب، لا لضعف، بل لأنه غير مطلوب في هذا المقام..
ثم إن الأدباء لم يكتبوا ليُنجزوا، ولا ليُبلّغوا خبرا أو يُحلّلوا واقعة، بل كتبوا ليُفكّروا، أو ليبوحوا، أو ليختبروا اللغة وهي تلد المعنى!.. لم يكن منتج النشرة يطاردهم، ولا القوالب تقيّدهم، ولا المنظومة تُملِي عليهم طول الجملة أو قصرها!..
أمّا الصحفي فهو ابن اللحظة وأسير الإيقاع، محكوم بالمساحة ومطالب بالسبق، ومحاسب على التأخير؛ فكيف يستوي البيانان؟
ويشتدّ هذا الإحساس حين تتأمل أن الصحافة - على مافيها من مفارقة - ترفع الذائقة، فكلما ازداد الكاتب تمرّسًا، صار أدقّ ملاحظة لعيوبه، وأقلّ رضى عمّا يكتب، وأشدّ قسوة على نفسه؛ فيظنّ أنه تراجع، وهو في الحقيقة صار يرى ما لم يكن يراه من قبل.
وهذا كلّه أمرٌ طبيعي، بل يكاد يكون حتميا لمن جمع بين الحقلين.. إذ الفرق ليس بين من شعر به ومن لم يشعر، بل بين من فهمه ومن استسلم له؛ فبعضهم ظنّ الأدب مرحلة عابرة، وبعضهم حسب أن الصحافة قد أفسدت قريحته، والحقيقة أن الخلل ليس في الصحافة ذاتها، بل في عدم الفصل بين الملكتين.
زبدة ما اطمأننت إليه، أن الخلاص لا يكون بترك الصحافة ولا بإنكار فضلها، وإنما بفكّ الاشتباكات، إن صح القول! فلكل مقامٍ لغة، ولكل كتابةٍ عقلها، ولا يُكتب الأدب بعقل الصحفي، ولا يُكتب الخبر بعقل الأديب.. ولا بدّ من وقتٍ للكتابة غير الوظيفية، كتابةٍ لا يُراد بها نشرٌ ولا تأثيرٌ ولا تحليل، بل مجرّد استعادة النفس، ولا بدّ من العودة إلى البطء، لأن الأسلوب الأدبي العالي لا يُولد مستعجلا، ولا يُستعاد على عجل، ولا بدّ من التكلّف الواعي، لا التكلّف المذموم؛ ذلك التكلّف الذي هو رياضة للنفس وتهذيب للملكة..
وألا يهمل أو يتهاون في القراءة، والقراءة هنا لا تكون قراءة محلّل ولا ناقد، بل قراءة متأدِّب.. فتُقرأ مثلا كتب الجاحظ لا لتُفكّك، بل لتُعاش، ويُقرأ التوحيدي لا لاستخراج الفكرة، وإنما لمصاحبة النبرة.. وهكذا تعود الملكة إلى موضعها، وتستعيد بريقها، وتخرج من خلفية التحليل إلى ذروة البيان.
ثم اعلم أن من يشعر بهذا القلق لم يفقد إبداعه؛ فالذي مات لا يسأل، والذي استحال آلةً لا يتحيّر!.. إنما هذا السؤال نفسه علامة حياة، ودليل على أن الملكة لم تُستنفد، وإنما أُشغلت بغير بابها.. ومتى أُعيدت إلى بابها، رجعت أسرع مما يُظن، لأن الجذور الكامنة لا تموت وإن طغا عليها حينا أمر شاغل.. |
|
| سؤالي هل ما كتبته الان في هذا المقال بقلم اديب ام صحفي؟ هو أكثر من رائع. يحضرني الان الخلاف الذي أثير مع إعادة إحياء اللغة منذ سنوات، وما أطلق عليه حينها اللغة العربية الحديثة المأخوذة من الصحافة. اراها قد ابتعدت كثيرا عن لغة الادب وعن كتب الفقه. فأصابنا الضرر جميعا. لكن هذا الفارق الذي أشرت إليه حقيقي والتحليل دقيق جدا. بارك الله فيك. |
|