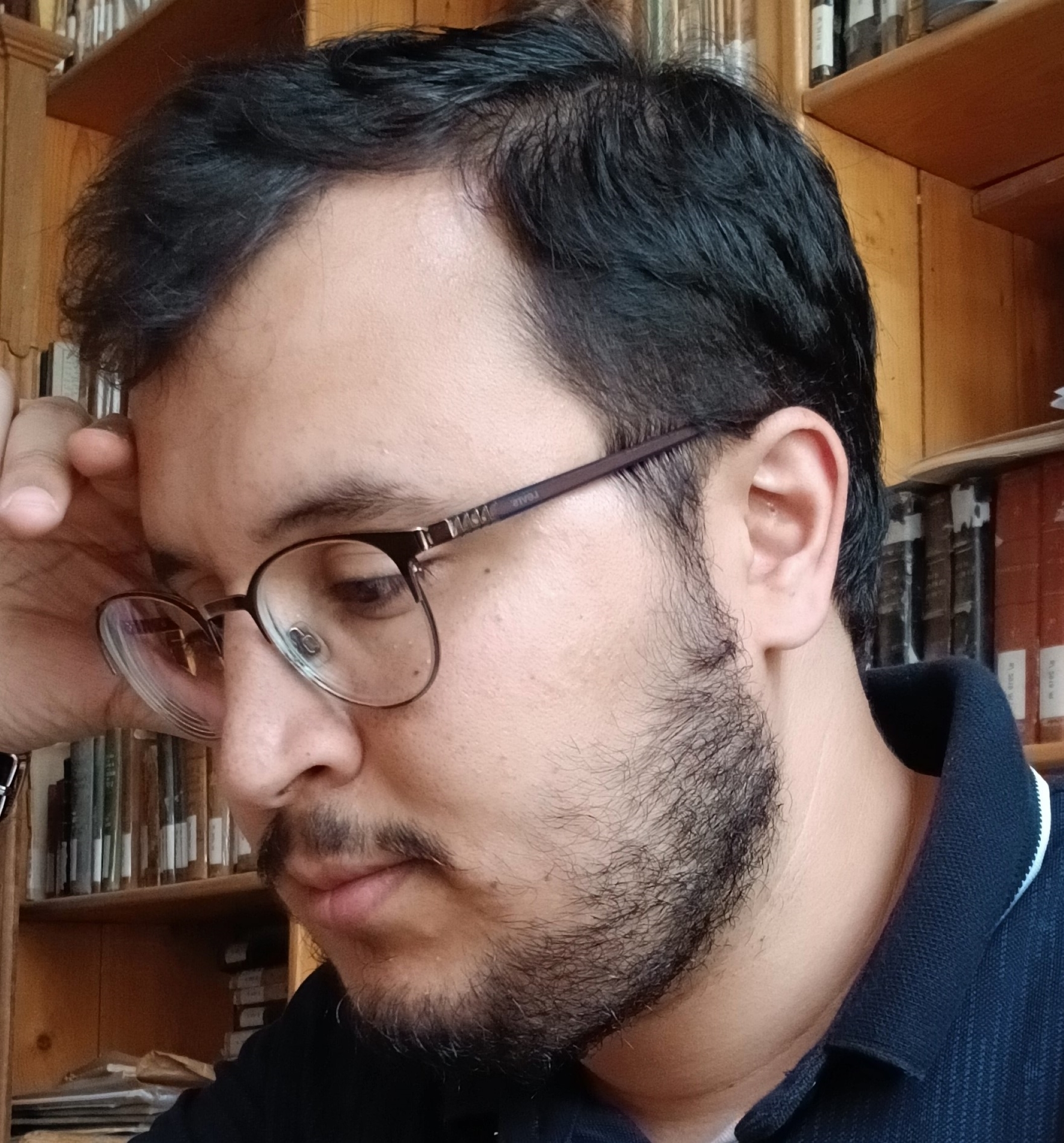 | عرض ونقد كتاب "صناعة البحوث العلمية وتحقيق النصوص العربية" للدكتور محمد خليل الزروقمحمد عكره النويري | مقالةتاريخ النشر: 2025/08/26
اقرأ للكاتب |
توطئة:كانت لمناهج البحث وطرق التأليف والتحقيق قواعد ومسائل مبثوثة في تضاعيف كتب أدب الطلب وأخلاق العلماء والمتعلمين، ثم بسط فيها القول بعض العلماء المتفنّنين كابن خلدون في (المقدمة)، وطاش كُبرى زاده في (مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم)، ومن بعدهما حاجي خليفة في (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)، ولعل السيوطي أول من أفرد لهذا الفنِّ تصنيفًا في ورقاته المسمّاة (التعريف بآداب التأليف)، ولا غرو أن تأتي أبحاثه قاصرة غير مستوفاة شأن كل من يكتب في علمٍ بِكرٍ لمَّا تتعاوره أقلام العلماء بالشرح، والتحقيق، والاستدراك، والتهذيب.
وفي منتصف القرن الماضي سلك مفتي بغداد الشيخ قاسم القيسي (1375هـ) مسلك السيوطي فوضع مصنّفًا سمّاه (الزهر اللطيف في مسالك التأليف)، استخرجه وأقامه من بطون كتب التراث، ثم جاءت من بعده كتبٌ ومقالاتٌ كثيرةٌ أخرجت هذا الفنَّ من طور النشوء إلى طور الكمال، وكان أصحابها على مشارب مختلفة، فمنهم الحداثي المُنبهر بمناهج المستشرقين، ومنهم التراثي المنغلق، ومنهم من قارب وسدّد.
والكتاب الذي بين أيدينا الآن طبع حديثًا قبل ثلاثة أشهر، وكان في الأصل كراسة جمعها مؤلفها مِمَّا أملاهُ في مادة مناهج البحث في كلية العلوم الشرعية والإفتاء في الدراسة الدنيا والدراسة العليا بين سنتي 1444 و 1446هـ = 2022 و 2024م، وأراد له مؤلفه أن يجعله موجزًا يشبه المتن، وإن لم يخله من كثير من الإيضاح والتفصيل والإشارة إلى المراجع أو التعريف بها، وبناهُ على خبرته بالتراث العربي الإسلامي طيلة ثلاثين عامًا، وما قرأه من المؤلفات في هذا الباب قديمًا وحديثًا، ثم صاغه ورتّبه على صورةٍ فريدةٍ لم يتّبع فيها طريقة أحدٍ في الهيئة أو المضمون.
البحوث العلمية؟وأول ما ابتدأ به المؤلف بيان المراد من البحوث العلمية، فقال في المقدمة: (وقصدت بالبحوث العلمية ما يكون في العلوم النظرية، المسمّاة بالإنسانية، لا العلوم العملية، فتلك لها طرائق أخرى، وتشارك هذه في كثير من النواحي، وهو أميل كما سترى إلى العلوم العربية والإسلامية). ولقارئ الكتاب أن يقول بل هو خالصٌ لبعضها، فإنَّ الأديب أو المؤرّخ لن يجد بغيته في هذا الكتاب كما يجدها اللُّغوي والفقيه والمحدِّث والمفسِّر، وللقارئ أن يَعيب الكتاب بذلك لولا أنَّ مؤلفه قدَّم لنا عذره بأنّه إنما وضعه ابتداءً لطلاب كلية العلوم الشرعية والإفتاء، وأنه أحبَّ أن يجعله مُوجزًا شبيهًا بالمتن.
مضمون الكتاب:من بعد المقدمة إلى آخر الكتاب عقد المؤلف عدَّة عناوين رئيسة وفرعية متصل بعضها ببعض دون فاصل، وربما تعذَّر على القارئ بسبب ذلك أن يربط الفصول السابقة باللاحقة، وأن يتصوّرها مرتبة في ذهنه آخذًا بعضها برقاب بعض، وبعد إطالة النظر في فصول الكتاب غلب على ظنِّي أنَّ المؤلف بنى كتابه على خمسة أبواب رئيسة، عدا المقدمة والخاتمة:
الباب الأول: تمهيد: جاء في أربع صفحات، واشتمل على آيات وأحاديث في الحث على طلب العلم، ثم بيانِ المعاني اللغوية والاصطلاحية لكلمة الصناعة، والبحوث، والمنهج، ثم إشارة موجزة عن تأليف علمائنا في كيفية التأليف وطرائقه، وعن مصنّفاتهم في فضل العلم وأدبه.
الباب الثاني: المنهج وأنواعه: جاء في صفحتين، ذكر فيهما المؤلف ثلاثة مناهج: أولها: منهج التفكير، وبحثه لا يكون في هذا الكتاب، وبيّن أنّ له عندنا نحن المسلمين ثلاثة علوم تحكمه، هي: أصول الفقه، وأصول الحديث، واللغة. والثاني: منهج العمل، ويدخل فيه منهج التناول. والثالث: منهج الكتابة. والمُراد بحثه في هذا الكتاب الثاني والثالث.
الباب الثالث: البحث وأنواعه: جاء في سبع صفحات، استفتحها المؤلف بذكر أغراض البحث، والمقصود من البحوث الجامعية من بحث التخرج إلى الدكتوراه. ثم بيّن معنى البحث العلمي، وذكر له مرتبتين، الأولى: الحدُّ الأدنى، ويكتفى منه بحسن التتبّع، وجودة الفهم، وإتقان العرض والترتيب. والثانية: المراتب العليا، ولا بُدَّ فيها من الاستخراج والزيادة. وبعد ذلك عرض لكيفية اختيار الموضوع وشروطه، ثم تحدَّث عن عمل المُشرف، ثم عن مدّة البحث. أما أنواع البحث فهي كثيرةٌ ومتنوِّعةٌ باعتباراتٍ مختلفةٍ، بيد أنَّ لها قسمين رئيسين، هما:
• بحث دراسةٍ لموضوعٍ.
• وبحث تحقيقٍ لنصٍّ.
الباب الرابع: بحث الدراسة: وجعله المؤلف على قسمين، هما:
• منهج العمل: حوى عدة فصول، ابتداءً من فصل (صوغ العنوان والخطة)، وانتهاءً بـ(المصادر والمراجع).
• منهج الكتابة: حوى عدة فصول، ابتداءً من فصل (كيف نكتب؟) وانتهاءً بـ(الصفّ على الحاسوب). وهذا الباب بشقّيه شمل نصف الكتاب.
الباب الخامس: التحقيق: شمل هذا الباب خمسة وعشرين فصلًا، استوعبت علمًا جَمًّا عن تحقيق المخطوطات وكيفية التعامل معها، وجاء هذا الباب في حجم ثلث الكتاب.
حلاوة السرد، وتحرِّي الاختصار، وجزالة اللغة:صاغ المؤلف كتابه على طريقة مبتكرةٍ غير معهودةٍ، وهي أنه استشرف إلى القارئ بنفسه ولم يجعل القرطاس وسيلةً بينهما كعادة المؤلفين، أي إنّه لم يجعل كتابه مسائل جامدةً جافًّةً يتلقَّفها القارئ من صفحات الكتاب على غير هُدًى، بل وجدنا المؤلف يُملي مسائل كتابه على القارئ مباشرةً ويُخاطبه بها عيانًا، ومن أجل ذلك لم أعدم أُنسًا أينما قلَّبت نظري في هذا الكتاب، وكأنَّ مؤلفه على مرأًى منِّي، يُلقي عليَّ المسألة تلو المسألة، وتارةً ينصحني، وتارةً يُحذّرني، وتارةً يأخذ بيدي إلى الحاشية فيوجّهني إلى مصادر قيّمة تزيدني علمًا ومعرفةً.
ثم إنّه عضد هذه الطريقة الحانية فكفانا شرَّ المسائل والتقسيمات والتفريعات التي هي إلى اللغو والحشو أقرب منها للبسط والزيادة، مما تجده في كثير من كتب هذا الفن. وإذا اضطره الاختصار إلى إغفال بعض المباحث التي ينبغي للقارئ أن يطلع عليها ولو لِمامًا عمد إلى الإشارة إليها في الحاشية مع ذكر أهم الكتب التي تناولتها، مثل مناهج البحث العلمي في أوروبا، اعتاض عن ذكرها بالإشارة إلى كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي (مناهج البحث العلمي)، ومثلها منهج التناول، أبدى رأيه فيها عند الحاشية بعد أن أوعز إلى القارئ مراجعة كتاب الدكتور فريد الأنصاري (أبجديات البحث في العلوم الشرعية).
وساعد المؤلف على جمال السَّرد، وتحِّري الاختصار، مع استيفاء المعاني، لغةٌ عذبةٌ أبانت أنَّ صاحبها من صَفوة البُلغاء المُبينين، ليس في تخيُّر الألفاظ الغريبة ولكن في سلامة اللغة، وجزالة الجملة، وحُسن تركيبها، ووجازة ألفاظها.
فرائد وفوائد، ونصائح وتوجيهات:لو لم يكن لقارئ الكتاب من فائدة إلا ما يعلق في ذهنه من ألفاظ ناصعة، وتراكيب بليغة، وبيان عال = لكفاه ذلك فائدةً ومغنمًا، فكيف وهو يعجُّ بالنكت اللطيفة، والمسائل الطريفة، والأبحاث الفريدة، فمن ذلك:
• الفرق بين الإنجاز السريع والعجلة: فـ(الإنجاز السريع والكثير إنما يُبنى على الخبرة الطويلة، والذخيرة الواسعة ... وعلى شيء آخر وهو الدأب في العمل والمثابرة، وهو خُلُقٌ غير العجلة، فالعجلة تخرج البحوث والأعمال غير ناضجة ولا تامة، دون إناها وقبل أوانها. والمطلوب من طالب العلم والباحث والمؤلف الدأب، أي العمل كل يوم مع الانكباب وإبعاد الصوارف واستثمار الزمن وأن يعطي كل شيء حقه من الجهد والزمن).
• أنواع الضبط: (والضبط عند علمائنا ثلاثة أنواع: ضبط القلم، أي برموز الحركات والشدة والسكون، وضبط الحروف، أي بالكلام، كأن يقال مفتوح الأول أو مضموم، أو بالحاء المهملة، والغين المعجمة، وهكذا، وضبط النظير، بأن يُذكر لفظ مشهور على الميزان نفسه، كأن يقال: في وزن قفل أو جعفر أو سفرجل).
• مزايا وآفات المكتبة الشاملة: (وهو برنامج نافعٌ جدًّا، وليتحرَّز من آفاته، وهي أنَ النصوص المرقونة فيه ليست مأمونة الصحة ... وليس ضبطها أيضًا مما يُعوّل عليه أو يُستنام إليه أو يُنقل إلى البحث على علاته ... ومن آفاتها بناؤها على كثير من الطبعات التجارية، وسقوط شيء من الكتاب في بعض المواضع، وخلوُّها من كتب لا غنى عنها في الجملة).
• شأن الباحث مع مَراجعه: (والباحث في المعتاد يعرف من الكتب والمراجع أكثر مما يقرأ، ويقرأ منها أكثر مما يقيِّد، ويقيد أكثر مما يستعمل ويستشهد).
• صفة الباحث: (والباحث كثير الشك، والحَدْس، والفروض).
• ذكر القرآن الكريم ضمن مراجع البحث: (وأستهجن أن يذكر القرآن الكريم في المراجع، فهو أرفع من أن يكون مرجعًا في بحث، بل هو هدى ونور وتبيان وشفاء وموعظة وذكرى لنا في كل شئون حياتنا، ومنها البحوث العلمية، وإنما أدخَلَ ذلك علينا المستشرقون، إذ كانوا لا يؤمنون بالقرآن كتابًا منزلًا من عند الله محفوظاً معجزًا، فهو عندهم مرجع من المراجع. إلا أن يكون البحث له تعلق بالمصاحف فتذكر المصاحف المستعملة ورسمها وضبطها ورواياتها وتواريخ طباعتها أو خطِّها).
• سبيل تجويد البحث: (وأن تغيب عن البحث أيامًا أو أكثر مما يصحِّح نظرك فيه، ويخرجك من الانغماس الذي يحجب عنك عيوبه. ولا بأس عليك أن تحذف ما تجد أنه من الزيادة التي يستغنى عنها، أو الإقحام على غير التئام أو نظام، ولا يَعِزَّ عليك أن تفعل، لأنك تعبت في جمعه ودرسه وكتابته، فهذا يقع كثيرًا، وليس كل ما قرأت أو جمعت أو كتبت خليقًا بالإثبات في بحثك، إن كان لا يفيد في موضوع البحث، أو لا يلائم بناءه وأجزاءه، أو يناكد اتساقه وانسجامه).
• ليس كل كتاب مخطوط يحقق: (وليس كل كتاب مخطوط صالحًا للنشر، وإن لم ينشر من قبل، ولا شك أن فيه فائدة ما، ولكن يجب أن يكون الأوْلى ببذل الجهد النصوص الغائبة عن المجتمع العلمي، وتفيد علمًا جديدًا ... فيجب الانتقاء والتحري فيما نتصدى له، ولا يكفي أن يكون الكتاب مما لنا به صلة، لأننا نعرفه أو تملكناه أو وقفنا عليه، أو لأن مؤلفه من بلدنا).
• فائدة نسيان المحفوظ: (ولا بأس عليه أن ينسى، بل خيرٌ له أن يقرأ وأن ينسى، فيكون ما قرأه قد استقرّ في المَلَكَة، واستكنَّ في السليقة، مع طول الزمن، وسَعة الاطلاع، فيأتي الكلام سهلًا عند الحاجة إليه، بغير أن يتعمده ويتكلفه، وتكون الأغراض قائدة له لا الألفاظ، والمعاني لا المباني).
• السبيل الأمثل في الكتابة: (ولا يحسن أيضًا كثرة المقدمات والتمهيدات والحواجز دون ما يريد الباحث قوله، أو أن يكثر من التسويف والوعود والتشويق ... وليلج إلى عين ما يريد، وليهجم على المعنى من أول الأمر، وليُعف القارئ من تجاوز مقدماتٍ ومداخلَ وحواجز لا تغضّ من البحث لو حذفت واستُغني عنها. وكل ما تظن أنه لن يُقرأ لا تكتبه).
• تجنّب الأساليب الأعجمية في التواضع: (ولا أستحب له الأساليب الأعجمية التي يُوصى بها ويُظن بها الدلالة على التواضع، من قبيل: يرى الباحث، أو يرى البحث، فالكِبر والتواضع في المعاني لا في الألفاظ، وطرائق العرب في التعبير خيرٌ وأوْلى، فيَستعمل الضمائر كما هي في لغة العرب، ولا بأس عليه أن يقول: بدا لي، وظهر لي، وأرى وأظن وأحسب، وهذا فيما وقفت عليه، ولم أجد ما يدل عليه، ولم أقف على صوابه، ولا يتَّجه لي صحته، ولم أدر ما معناه، ولا من أين أخذ، ولا علم لي بدليله، ونحو ذلك. وهذا شيء غير الفخر والإعجاب بالنفس الذي يظهر في طريقة كاتبه، وهو مذموم وممقوت).
• تواريخ الكتب والعلوم والأفكار والألفاظ: (وحق على العلماء أن يؤرخوا هذه الكتب، ودَيْنٌ على المغاربة أن يؤرخوا كتب علمهم، كالموطأ والمدونة. وقد اعتنى علماؤنا بتواريخ الدول، وتواريخ العلماء والأعلام، وفاتَنا تواريخ الكتب، وتواريخ الألفاظ اللغوية والاصطلاحية، وتواريخ الأفكار، ونحن أحوج ما يكون في هذا العصر إلى كل ذلك، ولا سيَّما في الألفاظ والأفكار).
• تاريخ كتابة المقدمة: (وأستحبُّ له جدًّا بل أكاد أوجب أن يختم المقدمة بتاريخ كتابتها، فهذا مفيد له ولغيره، وجهالة الزمان عَوَز شديد في العلم).
أخلاق الباحث:لم يهمل المؤلف الحديث عن الأخلاق الكريمة التي يجب أن يتحلَّى بها الباحث، فنراه ينثر في ثنايا الفصول وأعطاف المباحث بعض ما يتَّصل بها من الآداب والسجايا النبيلة، فمن ذلك:
• الإخلاص: (وأحسن الأحوال أن ينشئ البحث لا يريد به إلا العلم ... يقول إحسان عباس في التقديم لمجموع لبحوثه: لا أذكر أني كتبت بحثًا منها لأجل الترقية في إحدى الجامعات، ولا أذكر أني كتبت بحثًا واحدًا رجاء مكافأة مادية).
• لا تتزيّن بجهد غيرك: (يحسن إن دلَّك كتاب أو بحث على نصٍّ معيَّن، له أثر مهم في البحث، ولا يسهل الوقوف عليه = أن تذكر الذي دلَّك على هذا النص، فهو من تمام رد الفضل إلى أهله).
• اعرف مقدار علمك وأنزل كل شيء منزلته: (وليضع كل شيء في موضعه، وليزنه بميزانه، فللجزم موضع، وللظن موضع، وللتوقف موضع، وللإرجاء موضع حتى يفتح الله بالعلم والفهم، ولا يخلط بين ما حقه الجزم وما حقه الظن وما حقه التوقف، وذلك كله مَرَدُّه إلى الأدلة والشواهد، ومقدار ما بلغه من العلم، ومنازل الأدلة والشواهد، فمنها القوي ومنها الضعيف، ومنها الكثير ومنها القليل، ومنها ما هو عن الثقة ومنها عمن هو دونه، ومنها ما هو واضح ومنها ما هو مشتبه، وكذلك فلينزل كل شيء منزلته).
• أدب التعبير: (وليكن عفَّ اللسان والقلم إن نقد أو خالف أو استدرك، فللحوار طرق من الجدل بعضها أحسن من بعض، وللمعنى لفائف من المعاريض يكون حُسْنُه فيها، وللقصد ذرائع من اللُّحون يُجاز إليه بها، وللحق وجوهٌ من البيان يُولَج إليه منها. والحكيم من وضع كل شيء في موضعه، فقد يكون الشيء حسنًا في نفسه، فإن جاء في غير إبَّانه، أو وُضع في غير مكانه، أو تردَّىٰ بغير ثيابه، أو دخل من غير بابه - نَكِرَهُ مَن كان يعرفه، ومَجَّه مَن كان يُسيغه، وحال الحُسْنُ قبحًا، وعاد المدح قدحًا).
• الإنصاف: (ولا يتبع الباحث هواه، وليحترز قدر الإمكان من التحيُّز، وليكن منصفًا لغيره ومنصفًا من نفسه ... وقال الشيخ المُعَلِّمي: وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعمًا أنه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معنى، فأقرره تقريرًا يعجبني، ثم يلوح لي ما خدش في ذاك المعنى، فأجدني أتبرم بذاك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه، وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب، وإنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أوَّلًا تقريرًا أعجبني صرت أهوى صحته، هذا مع أنه لا يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش ولكنَّ رجلًا آخر اعترض عليَّ به؟ فكيف لو كان المُعترض ممن أكرهه؟).
جماليَّات:ومن مآثر الكتاب أيضًا أنه نبَّه الباحثين على بعض المسائل الجمالية التي من شأنها أن تخدم البحث وتكتب له القَبول، وكثير بل أكثر الباحثين يهملون هذا الجانب فيصدف الناس عن أعمالهم، فليس التهاون فيه بمحمود، وإنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، وهو سبحانه جميلٌ يحبُّ الجمال. فمما ذكره المؤلف وحقُّه أن يمتثل:
• ذم تكلف السجع في العناوين: (فإذا استقرَّ الباحث على دائرة البحث فليصُغ عنوانه، وليكن العنوان واضحًا دالًّا على مقصوده، لا زيادة فيه ولا نقصان ... والسجع المتكلف الملتزم دائمًا مذموم، كان يفعله المتأخرون من العلماء ولم يكن ذلك من عمل المتقدمين).
• حسن التنسيق والإخراج الطباعي: (ولا يتهاون في حسن التنسيق والإخراج الطباعي، فكثير من البحوث يذهب بفائدتها ورونقها ويقلل الانتفاع بها سوء صفِّها واضطراب إخراجها واختلاف أجزائها ... ومن تمام التحقيق وجماله حسن التنسيق الطباعي، بأن يطَّرد الاصطلاح، ويُعطى كلُّ شيء حقَّه، ويُختار الخط والحجم الملائمان للمتن والحواشي، وأن تضبط الفِقرات والعنوانات، وتنتظم الرموز والإشارات، وتنسَّق الفهارس والملحقات).
• الخط الجميل: (ومن تمامه أيضًا خط عنوان الكتاب بخط اليد لخطَّاط محترف، يعطي الكتب التراثية بهجةً ونورًا، فإن خُطَّت عنوانات الفصول كذلك جاء في غاية الجمال، وأما خطوط الحاسوب، ومثلها خطوط المتطفلين على صنعة الخط ممن تستكتبهم الدور التجارية فمن علامات التهاون والتفريط).
وبعد: فهذه لمحات موجزة لا تُغني عن قراءة الكتاب، كما أنها لم توفِّيه حقَّه، وكُلِّي رجاء أن يجد مؤلفه العالم الفذُّ سَعَةً من الوقت حتى يتمَّ ما ابتدأه فيكتب عن مناهج البحث، وأدوات الاستنباط، وآلات الفهم، على النَّحو الذي سلكه سلفنا الصالح، ولا بأس من الاستفادة بمناهج الآخرين دون إفراط ولا تفريط، فالحكمة ضالة المؤمن يتلقَّفها أنَّى وجدها، وشيخنا الكريم أهلٌ لذلك، ونحن نحبُّ أن نستفيد من علمه في هذا المبحث العويص وهو أحد فرسانه المعدودين، وعسى أن تحقق الأيام هذه الأمنية، وما ذلك على الله بعزيز.
والحمد لله رب العالمين.
محمد عكره النويري
طرابلس الغرب / السراج
2 ربيع الأنور 1447هـ |
|