 | الشعر الجاهلي وإعجاز القرآنمحمد خليل الزَّرُّوق | بحثتاريخ النشر: 2022/06/26
اقرأ للكاتب |
بسم الله الرحمن الرحيم
(1) جزى الله أخي الأستاذ أنس رفيدة خيرًا على هذه اليد التي أسداها إلى طلاب العلم بتصوير هذا الكتاب ورفعه على الشبكة، فقد كنت قرأته قبل نحو ثلاثين سنة، ثم لم أجده في هذه السنين الأخيرة مصورًا، فلما وقفت عليه في مكتبة الشيخ أحمد زروق في مصراتة في شهر كانون الآخر الماضي (يناير 2022م) اغتبطت به، واقترحت على أخي أنس أن يصوره وينشره، ففعل، شكر الله له، وللأستاذ أنس قناة على التليكرام سماها كناشة أنس، ينشر فيها فوائد ونوادر، ولعله يعتني بالمطبوعات والمخطوطات الليبية التي يعسر الوصول إليها فينشرها، وهذا الكتاب أحدها.
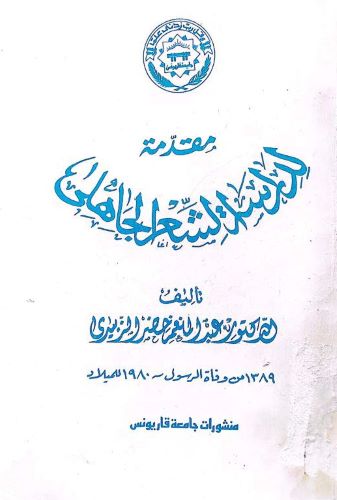 واسم الكتاب: "مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي"، ومؤلفه الدكتور عبد المنعم خضر الزبيدي، من العراق، لم أجد له ترجمة، غير ما أعلمه عنه، وهو أنه كان أستاذًا للأدب العربي في جامعة بنغازي في أواخر عقد السبعين من القرن العشرين وجل عقد الثمانين، وهو يقول في كتابه: إنه حصل على الدكتوراه سنة 1966م -ويبدو أن ذلك في جامعة أدنبرا في بريطانيا، وبإشراف بيير كاكيا Pierre Cachia، وقد أهدى إليه كتابه هذا- وإنه درَّس الشعر الجاهلي في جامعتي الموصل والبصرة ثلاث سنوات بعد هذا، والنقد الأدبي سنة أخرى، وإنه كتب فصول هذا الكتاب بين سنتي 1976 و1977م، ويقول: إن الآراء التي فيه نشأت في مدة تدريسه الأدب العربي بين سنتي 1966 و1973م، وإنه أراد أن يكون مدخلًا إلى دراسة مفصَّلة لخمس وعشرين قصيدة جاهلية اختارها، وجعل بعضها ملحقًا بالكتاب. ومقدمة الكتاب مؤرخة في 11/4/1978م، ونشرته جامعة بنغازي يوم كان اسمها جامعة قاريونس مؤرخًا سنة 1980م. واسم الكتاب: "مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي"، ومؤلفه الدكتور عبد المنعم خضر الزبيدي، من العراق، لم أجد له ترجمة، غير ما أعلمه عنه، وهو أنه كان أستاذًا للأدب العربي في جامعة بنغازي في أواخر عقد السبعين من القرن العشرين وجل عقد الثمانين، وهو يقول في كتابه: إنه حصل على الدكتوراه سنة 1966م -ويبدو أن ذلك في جامعة أدنبرا في بريطانيا، وبإشراف بيير كاكيا Pierre Cachia، وقد أهدى إليه كتابه هذا- وإنه درَّس الشعر الجاهلي في جامعتي الموصل والبصرة ثلاث سنوات بعد هذا، والنقد الأدبي سنة أخرى، وإنه كتب فصول هذا الكتاب بين سنتي 1976 و1977م، ويقول: إن الآراء التي فيه نشأت في مدة تدريسه الأدب العربي بين سنتي 1966 و1973م، وإنه أراد أن يكون مدخلًا إلى دراسة مفصَّلة لخمس وعشرين قصيدة جاهلية اختارها، وجعل بعضها ملحقًا بالكتاب. ومقدمة الكتاب مؤرخة في 11/4/1978م، ونشرته جامعة بنغازي يوم كان اسمها جامعة قاريونس مؤرخًا سنة 1980م.
ويقول في المقدمة: "قد أدهشني وأثار استغرابي ما وجدت بين القصائد الجاهلية من تشابه وتكرار... كنت أعزو ذلك إلى ضيق خيال الشاعر الجاهلي، وانحصاره في الواقع الحسي المادي الذي يحيا فيه، وإلى ضآلة ثقافته، وضيق بيئته وحياته، وإلى ما في بيئة البادية وحياتها من تشابه مطرد، وتكرار في الأحداث والمشاهد والمعالم والمواقف والسلوك، ولكني لم أكن قانعًا بهذا التعليل، كنت أحس على نحو غامض مبهم أن ثمة سببًا آخر أقوى وأعمق من كل هذا... لهذا كله كتبت هذه الفصول التي يضمها الكتاب محاولًا جهدي أن أكشف عن الطبيعة العامة للشعر الجاهلي" (ص7-11).
وانتهى في الكتاب إلى "أن الشعر الجاهلي كان شعرًا تقليديًّا في جملته، قد نظمه شعراء أميون أو شبه أميين، كانوا يقولونه على البديهة، ويتبعون فيه تقاليد شعرية قديمة متوارثة، ولم يكن الواحد منهم يختلف عن غيره في نهج قصيدته وتركيبها، وفيما يعالج من مواضيع، ويصور من مواقف ومشاهد... والعناصر الفردية الخاصة التي نجدها في قصائده قليلة جدًّا بالقياس إلى العناصر المشتركة" (ص267).
ثم قال: "فالشاعر الجاهلي راوٍ ومؤلف في الوقت نفسه، وقصائده إعادة أو تكرار لقصائد سابقة، وتركيب أو خلق جديد لها في آن معًا... وقصائده مجموعة من الأغاني والحكايات والأقاصيص المعروفة على نحو عام لأبناء قبيلته وربما أيضًا لأبناء القبائل الأخرى المجاورة لقبيلته أو المتحالفة معها. فالشعر الجاهلي يمثل أدبًا موروثًا مأثورًا نصيب الفرد فيه أقل بكثير من نصيب الجماعة، وكانت القبائل تتناقله تناقلًا شفهيًّا يعتمد على الذاكرة والممارسة الدائبة دون الكتابة والتدوين... وعلى هذا يصح أن نقول: إن القصائد الجاهلية التي بلغتنا ليست نتاج أفراد معدودين أو طبقة خاصة متعلمة، وإنما هي نتاج جماعي نشأ ونما واكتمل عبر أجيال كثيرة، تتمثل فيه تقاليد الجماعة أو الجماعات التي نشأ بينها ومعتقداتها ومواهبها وذوقها ولغتها الأدبية... وهي ليست نتاج الشعراء الذين تنسب إليهم إلا بمقدار ما لهؤلاء الشعراء من دور في إعادة نظمها وتركيبها وإضافة بعض العناصر الجديدة إليها، وفي هذا تظهر فردية هؤلاء الشعراء وقدراتهم الفنية التي تعتمد على كثر الرواية وسعتها، وعلى قوة الذاكرة، وعلى طول الممارسة والدربة في النظم، وعلى حدة الذكاء وقوة الطبع... ومن هنا كثرت في الشعر الجاهلي القصائد والمقطعات التي اختلف الرواة في عصر التدوين في نسبتها (ص 283-284)... وما دامت الرواية الشفهية هي الوسيلة إلى إذاعته ونشره، فإنه يبقى أبدًا في حالة تغير وتبدل، ولا يتخذ شكلًا ثابتًا محدًّدًا إلا حين يُدوَّن في صحيفة أو كتاب فيستقل بوجوده عن الرواة وجمهور المستمعين... فالشاعر الجاهلي لم يكن ينظم قصائده في معزل عن جمهوره، وإنما كان ينظمها مغنيًا أمام هذا الجمهور... ملاحظًا مدى استجابته ونوع هذه الاستجابة" (ص285).
وهذه كما ترى هي نظرية الشعر أو الأدب الشعبي بكل عناصرها، من شفوية الإنشاء، والاعتماد على الذاكرة، والاستمداد من الخزانة الجماعية للصيغ والقوالب وللصور والقصص، ومن تداول هذا المنتج على ألسنة الرواة بالزيادة والنقصان والتبديل، ومن أثر الإنشاد في هذه المرونة، إذ يراعي جمهور المتلقين، فهو منتَج غير ثابت، ونصيب الشاعر فيه ضئيل بالقياس إلى الجماعة، ومن هنا تكثر صور الأناشيد للقصيدة الواحدة، وتكثر النسبة إلى غير واحد من الشعراء، ويشيع التكرار والتقليد في الصيغ والصور والقصص.
(2) والكتاب من بعد ثلاثة فصول، (1) أحدها في أثر الأمية والغناء والارتجال في الشعر الجاهلي، (2) والثاني في المعلقات السبع ولغة قريش، (3) والثالث في حوليات زهير، (4) وفصل رابع في التطبيق على معنيين: وصف السحاب والمطر، ووصف الديار والظعائن، وملحق في قصائد جاهلية اختلفت أناشيدها.
(1) ففي الفصل الأول بيَّن علاقة الشعر بالغناء والحداء، وأنه قريض وقصيد بمعنى تقطيعه على الأوزان، وفيه فقرة عن الأوزان والعلاقات بينها (28-31)، ويستدل فيه بقول الجاحظ (163-255هـ) في البيان -ويصف هذا النص بالخطير-: "وكل شيء للعرب فهو بديهة وارتجال، وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكر ولا استعانة... فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب، وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسالًا، وتنثال عليه انثيالًا، ثم لا يقيده على نفسه، ولا يدرِّسه أحدًا من ولده... وكانوا أميين لا يكتبون، ومطبوعين لا يتكلفون" (ص35)، ويذكر مكان الرواية والحفظ من الإجادة والحذق، فغالب الشعراء كانوا رواة لشعراء سبقوهم، ويذكر الأمية وقلة الكتابة في العرب يومئذ، وأن ذكر الكتابة في شعرهم وتشبيههم الديار الدارسة بالخطوط لا يدل إلا على أنهم يرونها رموزًا غير مفهومة ولا دالة على معنى عندهم (ص59)، ويذكر ما يدل على أنهم كانوا يرتجلون الأشعار ولا يتأنون فيها ولا يتكلفون. ويقول: إن الباحث الذي ربط بين بعض خصائص الشعر الجاهلي والأمية هو إبراهيم أنيس في كتابه دلالة الألفاظ، قال: "ويبدو أنه تأثر في ذلك بما قرأ في الإنكليزية" (ص78)، وسنحتاج إلى هذه الكلمة من بعد، فكن على ذُكر منها، ويقول: إن إبراهيم أنيس لم يُعن بالآثار البعيدة لهذا المعنى.
(2) وفي الفصل الثاني بحث في حقيقة اختيار المعلقات بما أنه استُدل بها على كتابة بعض الشعر الجاهلي في معرض مناقشة قضية أن جُلَّه وُضع في الإسلام، فينفي خبر كتابتها وتعليقها على الكعبة، وسبَق إلى نفي ذلك ابن النحاس في شرحه للقصائد، ويذكر الزبيدي أوائل من استشهد بخبر التعليق من الباحثين المعاصرين، وهم نجيب البهبيتي وناصر الدين الأسد وبدوي طبانة، ومن ذكره من القدماء، وهم ابن عبد ربه وابن رشيق وابن خلدون ثم البغدادي في الخزانة، ويناقش كل ذلك، في تسميتها وعددها، ويرجح أن تسميتها المعلقات بمعنى القلائد من نفاستها، لا من تعليقها على الكعبة، فهي كتسمية السموط والمذهَّبات والـمُذْهَبات (ص94)، ويذكر ما ذكره ابن سلام (150-232هـ) من أن الشعر قليل في قريش وأن أشعارهم فيها لين، فلا يستقيم أن يكونوا حكَمًا في الشعر أو بين الشعراء كما جاء في الأغاني والخزانة، وأن الشعر في ربيعة وقيس وتميم، وأن شعراء المعلقات ليس فيهم شاعر حجازي، ويردُّ أيضًا ما شاع من فصاحة قريش وتخيرهم اللغة في المواسم، ويعارضه بأن علماء العربية لم يأخذوها منهم، ولكن من قيس وتميم وأسد وهذيل، وينتهي إلى أن هذه القصائد كانت من مشهور الشعر الجاهلي ومن أجود شعر أصحابها واختيرت على عهد الأمويين، وأنها ليست أجود هذا الشعر ولا تمثله تمثيلًا كاملًا دقيقًا (ص 199 و122).
(3) وفي الفصل الثالث يردُّ خبر حوليات زهير، بما أنه يفيد التأني والتنقيح والروية في بعض الشعر الجاهلي، وهو ينافي نظرية الشعر الشعبي، ويشير الزبيدي إلى أن هذا الخبر عن حوليات زهير أخذ به طه حسين وتلاميذه ومنهم شوقي ضيف، وهو خبر أورده الجاحظ وأخذه عنه من بعده، وخلت منه كتب أخرى هي عمدة في الباب، كفحولة الشعراء وطبقات ابن سلام والأغاني والموشح، وأطال في تقليب الأخبار والنظر في قصائد زهير وأناشيدها، وانتهى إلى أن الحوليات كأنها القصائد الطوال التي ينشدها الشعراء في المواسم (ص 161)، أي لا التي يقوم الشاعر على تثقيفها حولًا، ولكن ينشدها في رأس الحول، وأن التقليد والاتباع والتشابه في الشعر الجاهلي -ومنه ما وصف بالحوليات- مرده إلى أنهم كانوا يرتجلون ويقولون الشعر على البديهة بلا روية، وكانوا أميين لا يكتبون (ص173).
(4)
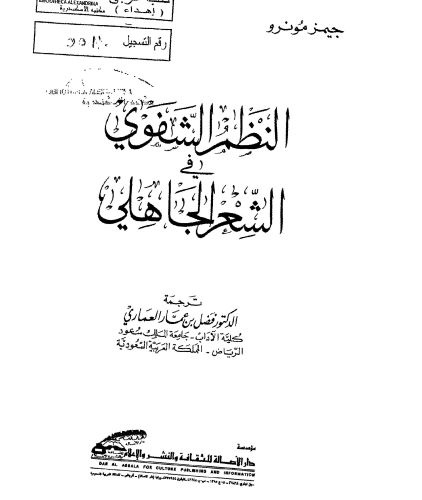 لم يذكر الزبيدي في كتابه مرجعًا أجنبيًّا واحدًا، على أن تطبيق نظرية الشعر الشعبي على الشعر الجاهلي ذهب إليها مستشرقون في عهد قريب من زمن نشر الزبيدي كتابه، وكان أقدمهم نشرًا فيها جيمز مونرو James .T. Monroe، وهو أستاذ أمريكي في جامعة كاليفورنيا في بركلي، إذ نشر في مجلة الأدب العربي Journal of Arabic Literature مقالة بعنوان: Oral Composition in Pre-Islamic Poetry سنة 1972 في العدد الثالث، وترجمها فضل بن عمار العماري بعنوان: "النظم الشفوي في الشعر الجاهلي" في كتاب نشر في الرياض سنة 1987م، وذكر في مقدمة الترجمة التردد في السبق إلى هذا بين الزبيدي ومونرو بناء على ما ذكره الزبيدي من أن الآراء في كتابه تكونت عنده منذ سنة 1966م حين انشغاله بالتدريس، وهذه دعوى لا نقدر على التحقق منها، ولا سيما أن أستاذه الذي أشرف على رسالته للدكتوراه في إنجلترا بيير كاكيا Pierre Cachia عمل في جامعة كولومبيا، وعاش طويلًا في مصر، وبقي على علاقة وثيقة به، وأهدى إليه كتابه، ووصفه بقوله: "وجدت فيه لسنين طوال، رعاية الأستاذ، وهداية الدليل، وعون الصديق"، فمن شبه المؤكد اطلاعه على هذه المقالة، ولا سيما أنها كانت فاتحة اتجاه في دراسة الشعر الجاهلي لدى مستشرقين أمريكيين، من أهمهم مايكل زوتلر Michael Zwettler فله رسالة في ذلك نشرتها جامعة أوهايو سنة 1978م. لم يذكر الزبيدي في كتابه مرجعًا أجنبيًّا واحدًا، على أن تطبيق نظرية الشعر الشعبي على الشعر الجاهلي ذهب إليها مستشرقون في عهد قريب من زمن نشر الزبيدي كتابه، وكان أقدمهم نشرًا فيها جيمز مونرو James .T. Monroe، وهو أستاذ أمريكي في جامعة كاليفورنيا في بركلي، إذ نشر في مجلة الأدب العربي Journal of Arabic Literature مقالة بعنوان: Oral Composition in Pre-Islamic Poetry سنة 1972 في العدد الثالث، وترجمها فضل بن عمار العماري بعنوان: "النظم الشفوي في الشعر الجاهلي" في كتاب نشر في الرياض سنة 1987م، وذكر في مقدمة الترجمة التردد في السبق إلى هذا بين الزبيدي ومونرو بناء على ما ذكره الزبيدي من أن الآراء في كتابه تكونت عنده منذ سنة 1966م حين انشغاله بالتدريس، وهذه دعوى لا نقدر على التحقق منها، ولا سيما أن أستاذه الذي أشرف على رسالته للدكتوراه في إنجلترا بيير كاكيا Pierre Cachia عمل في جامعة كولومبيا، وعاش طويلًا في مصر، وبقي على علاقة وثيقة به، وأهدى إليه كتابه، ووصفه بقوله: "وجدت فيه لسنين طوال، رعاية الأستاذ، وهداية الدليل، وعون الصديق"، فمن شبه المؤكد اطلاعه على هذه المقالة، ولا سيما أنها كانت فاتحة اتجاه في دراسة الشعر الجاهلي لدى مستشرقين أمريكيين، من أهمهم مايكل زوتلر Michael Zwettler فله رسالة في ذلك نشرتها جامعة أوهايو سنة 1978م.
ومن الطريف أن مونرو يؤكد في فاتحة مقالته أن الرأي الذي أذاعه طه حسن عن الشعر الجاهلي كان مستقلًّا عن مقالة مركليوث Margoliouth، كأنه يرد على دعوى من اتهموه بسرقة الرأي. وفي مقالة مونرو كل فكرة الشعر الشعبي وتطبيقها على الشعر الجاهلي، من شفوية الإنشاء والأداء، وأمية الشعراء، والقوالب المصوغة الموظفة في الوزن، ومرونة النص وعدم ثباته، وأن دعوى السرقة الشعرية لا تلائم هذا النوع من الشعر الجماعي الشفوي، وينقل عن آخرين أنه لو دُرِس الشعر النبطي في الجزيرة اليوم لوُجد فيه كثير من طرائق الجاهليين في الإنشاء والإنشاد والرواية، ويقسِّم التشابه أو العناصر المتكررة في الشعر الجاهلي إلى (1) جمل صغيرة أو كبيرة تتردد بحروفها، (2) أو أبنية نحوية، (3) أو ألفاظ، وكل ذلك يرتبط بأوزان مخصوصة، ثم إنه يفترض أنه يمكن تبين خصائص أسلوبية قبَلية أو إقليمية تفيد في تعرف العلاقات بين الشعراء وأزمنتهم، وفي تعرف الصحيح والمنحول أيضًا.
وأجرى أيضًا دراسة تطبيقية على بعض الدواوين، واختار منها قوالب مصوغة، ووجد أن نحو 33% منها وُجدت عند شعراء جاهليين، و9% منها وجد عند شعراء محدثين كانوا قارئين كاتبين، وكانت النسبة متقاربة على هذا النحو في كل مرة. ويذكر أن العناصر الوثنية في الشعر الجاهلي استبعدت في الإسلام، بما أن الرواية كانت تجري على نحو من المرونة في الزيادة والنقصان والتبديل، فما عندنا الآن قريب جدًّا مما قيل، ولكنه ليس هو هو على وجه الدقة.
(5) وكان الدكتور عادل سليمان جمال نشر شرحًا لهذه النظرية في مقالة بمجلة مجمع اللغة العربية القاهري بعنوان: "الشعر الجاهلي في ضوء نظرية باري لُورْد"، سنة 1987م الجزء 61، ثم أعاد نشرها كما هي في مجلة معهد المخطوطات العربية سنة 1999م مجلد 43 ج2 بعنوان: "هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل؟"، وقد كان الدكتور عادل أستاذًا للأدب العربي في جامعة أريزونا مدة من الزمن، وقال في ختام البحث في المرة الأولى: "وبعد فهذه خلاصة النظرة الجديدة للشعر الجاهلي، عرضتها كما هي، ولي رد مفصل إن شاء الله في القريب، وآمل أن يتصدى لها الباحثون بالبحث والنقد"، وقال في المرة الآخرة أي بعد اثنتي عشرة سنة: "وبعد هذه خلاصة أبحاث الأساتذة الأمريكيين في تطبيقهم لنظرية باري - لُورْد على الشعر الجاهلي، عرضتها كما هي، ولم أعلق على شيء فيها، وآمل أن يتصدى لها الباحثون بالبحث والنقد، ولي رد مفصل على هذه النظرية إن أذن الله تعالى". ولم أطلع على ما سماه ردًّا حتى اليوم. وللدكتور عادل بحث قديم عنونه بقوله: "الشعر العربي وظاهرة التداخل والاختلاط"، نشر في مجلة المجلة في مصر سنة 1966م عدد أيار، حاول فيه شرح اختلاف الرواية والنسبة في الشعر القديم، ورد ذلك أولًا إلى تعويل كثير من العلماء على الحفظ دون الكتاب، ثم اتفاق القصائد في الوزن والمعنى والقافية، واشتهار بعض الشعراء بنوع من الشعر كالنسيب أو الرثاء فيُحمل عليه ما هو أشكل بما اشتُهر به، وفي النسيب يكون اسم المحبوبة واحدًا فينسب الشعر إلى غير واحد ممن شبَّبوا بمن لها نفس الاسم، وتتشابه أسماء الشعراء أيضًا وتتقارب، واتحاد الممدوح أو المهجو أيضًا، وإغارة بعض الشعراء على شعر بعض، وغير ذلك مما ذكر. وكأن الدكتور وجد في نظرية الشعر الشفوي المرتجل بعض التفسير لما اشتغل به قديمًا من اختلاط الأشعار بعضها ببعض.
(6) وكنت من أيام الدراسة في جامعة بنغازي في عقد الثمانين -وقد قرأت كتاب الزبيدي، وكان مؤلفه درَّسنا الشعر الجاهلي- مائلًا إلى صحة هذه النظرية في فهم هذا الشعر، ومن الواضح أنه كان فيها شِبه مناقضة لرأي مركليوث في أن الشعر الجاهلي موضوع في الإسلام، وتفسيرٌ لما استدل به، ولا سيما خلوه من الآثار الوثنية والنصرانية واليهودية، فالرواة تعودوا على شيء من التصرف في الشعر، على أنه قد بقي بعض من الشعر الدال على أديان الجاهليين (انظر الشهاب الراصد لمحمد لطفي جمعة 85-92).
ثم بدا لي أن كينونة الشعر الجاهلي على هذا النحو من التشابه في التراكيب والصور والقصص والأساليب فيه وجه مهم من وجوه إعجاز القرآن للعرب، بل هو أول وجوهه، ذلك أن ما تحدى به القرآن الناس هو أن فيه الدليل على أنه لا يكون من كلام البشر، لأنهم لا يقدرون عليه، وذلك مستمر على الزمن ومن وجوه كثيرة، ولكن العرب لما كانوا أميين، بمعنى أنهم لا علم لهم بالكتب المنزلة السابقة، ولا لأكثرهم وسيلة العلم وذلك القراءة والكتابة، وكان الشعر -كما قال ابن سلام-: "في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهى حُكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون"، و"كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه"، كما روى ابن سلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهم مع هذا أمثالهم وخُطبهم وسجع كهانهم، لما كان الأمر كذلك جاء القرآن آية على النبوة، عربيًّا مبينًا، كما وصفه الله، ولم يكن لدى القوم علم أصح من الشعر، ولذلك وصفوا النبي ﷺ تعنتًا وعنادًا بأنه شاعر، وقد علموا أن ما جاء به من الوحي ليس بشعر، ولا يكون شعرًا، بل هو نوع مستقل من الكلام ليس شعرًا ولا نثرًا ولا سجعًا، ولا خطابة، ولا كهانة، وليس إلا قرآنًا كما سماه الله، وما وصفوه بأنه شعر إلا لأنهم وجدوا فيه سمو البيان، وعلو البلاغ، وهو ما يتوخاه الشاعر في شعره، ولكنهم مستيقنون أنه ليس له أوزان الشعر ولا قوافيه، وأيضًا ليس له طرائق الشعراء في القول، ولا فيه أساليبهم، بل ليس له طرائق العرب في مناحي القول وسياسة الكلام، فهو عربي في بنيته العميقة من الصوت والصرف والنحو، أي في النظام الأول وجوهر اللسان، لكنه مباين له في صيغ الاستعمال وتصريف القول، وهو مستوى آخر غير الأول، فهو عربي في المستوى الأول، غير معهود للعرب في المستوى الثاني، فإذا سمعه العربي علم أنه يجري على أساس لسانه في قاعدته الأولى، ولكنه لا يستمد مما تعارفه العرب من مخزن التعبير الذي فيه الصيغ والصور والقصص والتراكيب المستقرة المعلومة التي يتبع فيها بعضهم بعضًا، ويسيرون فيها في نهج ممهد، وطريق مسلوك، ولا سيما الشعر الذي هو ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم، ولم يكن لهم علم أصح منه، وإذا سمع العربي القرآن في زمن نزوله وعاه وبلغ شغاف قلبه، وعلم يقينًا أنه يصدر من مشكاة أخرى غير ما عهد وألِف، وأنه لا يقدر على أن يأتي بمثله، وكيف يأتي بمثله والعربي يستمد من مخزن تعبير مألوف له، وهذا القرآن لا يستمد منه، فهو إذًا له مصدر آخر، وهو مصدر إلهي بلا شك، لأنهم هم أصحاب اللسان، ولا ناطق بالعربية في ذلك الزمن غيرهم، ولهم علم تام بهذا البيان، وكيف يكون، وكيف يتصرف، فمن أين يأتي كلام عربي مباين لكلام العرب في التعبير والتصوير وقوالب القول المستقرة المعتادة؟
وهذا كما ترى شيء آخر غير البلاغة ونفوذ البيان إلى المعاني ودقة النظم وجودة السبك وحلاوة اللفظ وطلاوة الأسلوب، فهذه يتفاوت الناس في تقديرها وفي تذوقها وفهمها، فليست المدخل الأول في الإعجاز وإقامة الحجة والإفحام، لكن كل عربي في ذلك الزمن يتذوق منه أنه عربي وأنه مع ذلك مباين لكلام العرب، فلا يقوله عربي. ولذلك ينبغي تقييد عبارة الشاطبي (-790هـ) في الموافقات (دراز 2/65) أن القرآن "أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها" التي يلهج بها كثير من العصريين، بهذا الفهم الذي شرحت، فإنه إنما عنى الشاطبي الدلالات كالعام والخاص والظاهر والإشارة والترادف والاشتراك، ولا شك أنه يشمل (1) الحروف، وهو ما نسميه الأصوات، (2) وصيغ المفردات ودلالاتها، وهو ما نسميه الصرف، (3) وصيغ الجمل ودلالاتها، وهو ما نسميه النحو، (4) وصيغ الجذور صوتًا وصرفًا، وهو ما نسميه متن اللغة، وفي القرآن مع ذلك -بل فوق ذلك- في استعمال المفردات وفي الأساليب ما سماه الشيخ الطاهر بن عاشور: (1) "مبتكرات القرآن"، وعقد له فصلًا في مقدمة تفسيره، وأمثلة منه مبثوثة في التفسير، كأخذ العفو وأكل المال والمراودة عن النفس، والتمثيل بالكلب اللاهث، وببيت العنكبوت، والكناية بشيب الولدان، وتركيب (فاسأل به خبيرًا) و(أين تذهبون)، وهو كثير جدًّا، ويدخل فيه (2) "الألفاظ الإسلامية" كالصلاة والزكاة والتقوى والجاهلية والمسجد الأقصى، (3) و"عادات القرآن"، وهو ما سمي حديثًا بـ "مصطلح القرآن"، كذكر المطر في العذاب والغيث في الرحمة، واقتران الصلاة والزكاة، والجوع والخوف، والمهاجرين والأنصار، والإشارة بهؤلاء إلى المشركين إن لم تبين بكلمة، وحكاية المحاورات بقال بلا عطف (4) ويدخل فيه الفروق في المتشابه، لأننا قد علمنا كثيرًا من الفروق مما يظن به الترادف، وما عجزنا عن تفسيره لا يلغي الأصل، وكان الشيخ ابن عاشور أحيانًا يفسر المترادف بمجرد التفنن، كاستعمال الإتيان والمجيء في سورتي الحجر والفرقان، وليس ذلك بصواب، بل يجب الإقرار بالعجز فيما لا نعلم، بدليل ما تبيناه من كثير من الفروق.
وما أعنيه كما هو واضح يشمل كل هذا، وهو أوسع من هذا، وهو طريقة القرآن في التعبير التي لم يعهدها العرب، في ظاهرها وباطنها، مع أنهم لم ينكروا شيئًا منها، حتى إنهم لم ينكروا الحروف المقطعة في أوائل السور، ولا تفصيل الآي، ولا تسوير السوَر، ولم يعيبوا عليه شيئًا من أسلوبه وبيانه، ولم ينكروا عليه ما وصف به نفسه من أنه عربي، ومن أنه مبِين ومفصَّل ومُحْكَم وغير ذي عوج، وأقروا بأنه في غاية من البيان لا تدرك، وأقروا بتأثيره في سامعيه، حتى إنهم تواصوا بألا يستمعوا إليه، وأن يلغُوا فيه، وقال عتبة بن ربيعة كما في سيرة ابن إسحاق وغيرها: "قد سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة"، وقال الوليد بن المغيرة فيما روى الحاكم والبيهقي في الدلائل والشُّعَب وغيرهما: "والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطَلاوة، وإنه لمثمرٌ أعلاه، مُغْدِق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلَى، وإنه ليَحْطِم ما تحته"، وما كان قولهم فيما حكى القرآن عنهم: (لو نشاء لقلنا مثل هذا) إلا عنادًا وتكبرًا، لأنهم لم يقولوا ولم يقل غيرهم ولن يقول أحد. ولعلك تتبين في كلمة الوليد هذه أنه قسم صفة القرآن قسمين، قسمًا في المباينة للكلام المعهود عندهم، وقسمًا في علو طبقته في البلاغة.
ومن العادة في الأساليب الأدبية المستحدثة أن يكون لها جذور فيما سبق، ثم أن يكون لها فروع فيما يلحق، فيحذو الناس حذو الأسلوب ويبدعون ما وسعهم الجهد، كما في فنون: المقامات والموشحات وشعر التفعيلة والشعر المسرحي والقصة والرواية (أشير إلى هذا المعنى في كتاب إعجاز القرآن 378 المنسوب للباقلاني)، ولكن القرآن بقي قرآنًا غير مسبوق وغير ملحوق، ويعلم كل خبير باللسان العربي وبأدب العرب، من مؤمن بالقرآن وغير مؤمن به، أنه لم يُنسَج على منوالٍ سبق، ولا استطاع أن ينسج على منواله من بعدُ أحد. ولكن الحجة في زمن النبوة على هذا أبين، لأنه جاء بلسانهم على غير أسلوبهم، وقصارى كل بلغائهم من شعرائهم وخطبائهم أن يقول كما يقول الناس، وأن يمتحوا من حوض مورود، وأن يسيروا في نهج معلوم، وسبيل مطروق، فمن أين جاء هذا القرآن العربي في لسانه، على غير ما ألفوه في بيانه، في قالبه وإيقاعه وأسلوبه وتصريفه للقول؟
(7) ولتعرف مكان هذا الفهم من تبين إعجاز القرآن انظر إلى فهم الناس للإعجاز البياني للقرآن ما هو؟ وكيف اختلفوا في معناه وفي وجه ذلك وكيف كان؟ ومن أين جاء؟ بل في الإعجاز برمته.
وانظر في ذلك مثلًا ما كتبه ابن حزم (384-456هـ) في الفصل (ط صبيح) 3/10-14، ففيه مناقشة طويلة لهذا، وهو يرى أن إعجازه ليس لأنه في أعلى درجات البلاغة، ولكن لأنه خارج عن المعهود، لكنه لم يبين معنى خروجه عن المعهود، ويسوق قوله تعالى: (وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورًا) دليلًا على ذلك، لأنه -كما قال- ليس إلا سردًا لأسماء، ويغفل عن مساقه وترتيبه وما قبله وما بعده، فقد جعل الإيحاء ثلاثة أنواع، إيتاء الزبور داود، وتكليم موسى، والثالث الإيحاء إلى سائر الأنبياء، وهو نوع الإيحاء إلى نبينا ﷺ وهو معطوف على (أوحينا) الثاني من قوله: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده)، وفيه تفصيل بعد إجمال، وبعده إجمال آخر في قوله: (ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلًا لم نقصصهم عليك)، وكل ذلك تمهيد لذكر قطع معاذير البشر: (لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل)، وسبق ذلك ذكر إيمان الراسخين في العلم بالوحي المحمدي، فترتيب الأسماء في نفسه مجال للتأمل والتدبر، وهي متعاطفة ومعلقة بالفعل (أوحينا)، وهو منظوم بالعطف في سلك الفعلين السابقين وما تعلق بهما، وكل ذلك كتلة واحدة، بل هو متصل بما قبلَ قبلِه وما بعدَ بعدِه، وبالسورة كلها على سبيل الالتحام والنسيج الواحد.
وانتهي ابن حزم إلى قوله (3/12-13): "فإن قالوا: فقولوا أنتم: هل القرآن موصوف بأنه في أعلى درج البلاغة أم لا؟ قلنا وبالله التوفيق: إن كنتم تريدون أن الله قد بلغ به ما أراد فنعم، هو في هذا المعنى في الغاية التي لا شيء أبلغ منها، وإن كنتم تريدون هل هو في أعلى درج البلاغة في نوع كلام المخلوقين فلا، لأنه ليس من نوع كلام المخلوقين لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه، وبرهان هذا أن إنسانًا لو أدخل في رسالة أو خطبة أو تأليف أو موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان خارجًا عن البلاغة المعهودة جملة بلا شك، فصحَّ أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلًا، وأن الله منع الخلق من مثله، وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الخلق"، فانتهى إلى القول بالصَّرفة، أي الإعجاز بالقدرة، لا بآية النبوة نفسها.
ولست في حاجة إلى ذكر المزيد من دلائل الحيرة والاختلاف في معنى الإعجاز، فلك أن تنظر في كتاب أرخ للآراء في معنى الإعجاز، وهو كتاب: "فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى العصر الحاضر" لنعيم الحمصي (1955م)، وكتاب آخر هو "إعجاز القرآن البياني" للدكتور حفني محمد شرف (1970م)، وثالث هو "الإعجاز في دراسات السابقين" لعبد الكريم الخطيب، (1974م)، وهما أقل استقصاء من الأول، وغير ذلك كثير، ومن أجمع كتب الأولين كتاب السيوطي "معترك الأقران في إعجاز القرآن".
(8)
فبنا ننظر في تأريخ الأستاذ محمود محمد شاكر لمعنى الإعجاز، وفهمه له، وإنما اخترته لأمرين، لأنه تتبع تاريخ معنى الإعجاز البياني تتبع فحص وتحقيق، ولأنه وصل بين قضية الشعر الجاهلي وقضية الإعجاز، وقد نظرت في الكتب التي ناقشت الدكتور طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي" (للرافعي والخضري والخضر ولطفي جمعة والغمراوي ووجدي) فما وجدت فيها هذا المعنى، حتى إني اتهمت فهمي فراجعت لذلك تلخيص الدكتور ناصر الدين الأسد لها في كتابه "مصادر الشعر الجاهلي". والشائع عند الناس في خطورة قضية الشعر الجاهلي أنه يُستشهد به في تفسير القرآن والحديث، ويستشهد به في العربية، ثم هو أقدم مثال معروف للشعر العربي والأدب العربي، ولا يزيدون على ذلك أن ثبوت صحة بعض من الشعر الجاهلي له مدخل في تحقيق معنى إعجاز القرآن كما شرح الأستاذ شاكر في رسائله في الإعجاز، ومنها مقدمته لكتاب "الظاهرة القرآنية" لمالك بن نبي.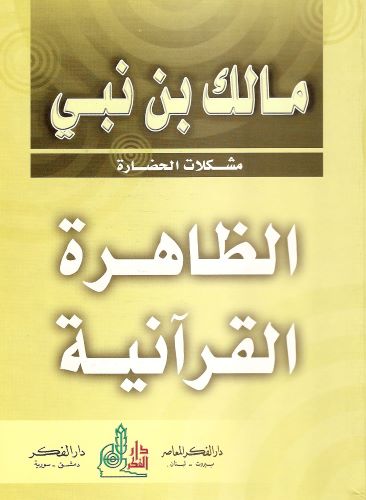
وقد أشار الأستاذ مالك إلى هذا المعنى أيضًا، وذكر زَعْم مركليوث وضع الشعر الجاهلي في سياق التلقي من الثقافة الغربية في كل الشئون ومنها الشئون الدينية، وتغلغل أفكار الاستشراق في عقول المسلمين، ومنهم كثير من الدارسين في الغرب، مع ما فيها من هوى سياسي وديني، والصريح منها أهون من المستتر، ويقول: إن ذلك يتجاوز الأدب والتاريخ إلى ما سماه "منهج التفسير القديم" الذي يجعل الشعر الجاهلي أساسًا في "الموازنة الأسلوبية"، كذا جاء في الكتاب، وهو لا يعني علم التفسير المعروف حَسْبُ، كما فهم الأستاذ شاكر، ولكن يعني فهمنا لعلوم القرآن جملة ومنها التفسير والإعجاز، وفي هذا المعنى ألَّف كتابه، وأظن مأتى ذلك عجمة الكاتب والترجمة، فأراد مركليوث -كما قال الأستاذ مالك- أن ينسف منهج التفسير القديم، يريد منهج الموازنة بين القرآن وبلاغة العرب في أشعار الجاهليين.
ويرى الأستاذ مالك أنه لا يستطيع المسلم اليوم أن يوازن بين آية من القرآن وشيء من الأدب الجاهلي ثم ينتهي إلى حكم موضوعي، وربما استطاع ذلك طائفة من العلماء لهم أدوات التذوق العلمي، وأما عامة الناس فلا لهم ذوق الجاهلية الفطري، ولا لهم ذوق الخاصة العلمي، فيقعون في الحيرة في قضية هي أمس القضايا بحقيقة الدين، سواء منهم من كانت ثقافته محلية أم كانت أجنبية، والمعجزة أو الآية يجب أن يَقْدِر على إدراكها كل من يكون مقصودًا بتبليغ الدعوة، أي في كل زمان ومكان ما دام الوحي المحمدي ختام الرسالات، فيجب أن يكون للإعجاز وسائل أخرى في غير عبارة اللغة، وهذا يحتاجه المسلم وغير المسلم، وهو يُظهر قصور وسائلنا ولا سيما فيما يتعلق بتواريخ الكتب السابقة وترجماتها. هذا ملخص المدخل الذي كتبه الأستاذ مالك للتعريف بمنهج الكتاب في فهم إعجاز القرآن والداعي إليه.
ثم يقدم الأستاذ مالك بتمهيد آخر في الإيمان بالألوهية وبالنبوة، لأنه لا معنى للحديث عن إلهية القرآن دون أن يكون ذلك مبنيًّا على الإيمان بالله وبأنه يوحي إلى من يصطفيه من البشر، ثم مدخل ثالث في الثبوت التاريخي للقرآن، إذ نسبته إلى ما جاء به محمد بن عبد الله ﷺ وأنه دُوِّن في حياته، وأُخِذ عنه مقروءًا ومكتوبًا، لا شك فيها من الوجهة التاريخية، وهذا ما لم يتحقق لكتب الدين الأخرى.
يلي ذلك فصل في مكانة السيرة النبوية من الظاهرة القرآنية، وهو فصل في صلب الكتاب، إذ فيه منحى من الاستدلال بها على علوية القرآن، وهو ما سلكه قبلَ كتاب الأستاذ مالك بقليل الدكتور محمد عبد الله دراز: "مدخل إلى القرآن الكريم"، وحاصل الفصل أنه لم يتصل بمؤثر علمي أو ديني، كأنه يقول: إنه من هذه الجهة صفحة بيضاء لم يُخط فيها سطر، مع ما كان في خُلقه ﷺ من الجزالة، ومن شهرته بخلال الاستقامة والأمانة، وهو المعنى الذي جاء في القرآن: (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذًا لارتاب المبطلون)، وأما ما كان عليه القرشيون من دين فلم يشاركهم في عبادتهم واعتزلهم، وما كانوا عليه خليط من الوثنية وبقايا دين إبراهيم، وينفي الأستاذ مالك ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أنه كان يتطلع إلى أن يكون له شأن في قضية الدين مستدلًّا الأستاذ مالك بالقرآن بما أنه وثيقة تنتسب إليه وإلى ذلك العصر حتمًا، وذلك قوله: (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك)، وهنا يأخذ الأستاذ دراز فيما كتب من مقدمة لكتاب الظاهرة القرآنية على الأستاذ مالك أنه سلَّم لجمع من المستشرقين افتراضهم أن النبي ﷺ اعتكف منذ زواجه واعتزل الناس، ليبنوا على ذلك بشرية القرآن، وأن ما فيه من معان كبيرة لا بد له من مدة طويلة من التفكر، على أن هذه العزلة لم تثبت في التاريخ، ولم يزد اعتكافه على شهر قبل نزول القرآن يعود فيه إلى أهله ليتزود، وسبق ذلك الرؤيا الصالحة تتحقق مثل فلق الصبح، وكل ذلك في سن الأربعين، وهو ما أمر القرآن النبي ﷺ أن يحاجَّ به قومه، من أنه لم يبدُ منه شيء من هذا الأمر قبل نزول الوحي: (قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون)، ولم يُنقل عن تلك المدة من حياته إلا مشاركته في تجديد بناء الكعبة، وأنه رزق فيها أكثر أولاده، وما ذاك إلا لأنه عاش كجمهور قومه، إلا ما امتاز به من أصالة الرأي، وعظمة الخلق، واعتزال الأوثان.
ومن هنا يرى الأستاذ مالك في دراسة السيرة تعرُّفًا على السمو النفسي والعقلي لشخصية الرسول ﷺ وهو ما يُمكِّن من تلقي شهادته هو على الوحي، ويقينه به، وهو ما يشير إلى نحو منه قوله تعالى: (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك)، ثم يكون في التمايز بين ذات المتلقي وذات المبلِّغ في نزول الوحي، وهو جبريل، وبين ذات المتلقي وذات المتكلم في خطاب القرآن، وهو الله سبحانه، حتى في استعمال الضمائر، ثم في التباين بين أسلوب كلام النبي ﷺ وأسلوب القرآن - ما يفيد في فهم الظاهرة القرآنية، وأنها ليس مصدرها نفس النبي ﷺ على نحو من الأنحاء.
وهكذا يستنطق الأستاذ مالك بن نبي الخصائص الخارجية للوحي كطول المدة وهي ثلاثة وعشرون عامًا، فهو إذًا ليس أمرًا عارضًا أو خاطفًا، والفتور في أحيان وانتظار نزوله في قضايا فيها حرج ولها إلحاح كحادثة الإفك، والتنجيم المساير لأحداث السيرة، وهو ذو أثر نفسي وتربوي، وهو ما عبر عنه القرآن بقوله: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذللك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا)، وأسلوب الجزم والتفصيل والإحاطة في تشريع الأحكام، كما في آية المحرمات من النساء، وهو لو كان بشريًّا لتطلب أحوالًا من التفكر، وأطوارًا من الزمن.
وعلى أن الأستاذ مالكًا أراد مجانبة الدرس البلاغي في الاستدلال على إلهية القرآن وجد نفسه مضطرًّا إلى شيء من النظر في بيان القرآن، وإن كان لا يجعله في المقام الأول مما يجب أن يتوجه إلى الدرس المعاصر في إعجاز القرآن لما سلف، وهو يفهم نحو قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) في حدود التحدي البياني، ويشير إلى أن الظاهرة القرآنية فريدة في تاريخ اللغات، فاللغات تتنقل في الأطوار بالتدرج، ومجيء القرآن باللسان العربي أشبه بـ "الانفجار الثوري المباغت" (ص 191) في ألفاظه الجديدة، وفي استعماله للمفردات العربية، وفي وضع الجملة موضع البيت الموزون، كذا يقول.
ثم ينتقل إلى مضمون الرسالة القرآنية ويلاحظ تنوعها الكبير من الذرة إلى المجرة، ومن غيب الماضي إلى غيب المستقبل، ومن خلق الإنسان إلى أطواء النفس، ومن الأمم البائدة إلى الحضارات الباذخة، ومن وصايا الأخلاق إلى سير الأنبياء، وهو يجمع الرحابة إلى العمق، "إنه بناء فريد ذو هندسة ونِسَب فنية تتحدى المقدرة المبدعة لدى الإنسان" (ص 196)، ففِكْر الإنسان وبيانه يحكمه الزمان والمكان والحال، ولا قدرة للرسول ﷺ ولا لغيره على هذا الاتساع وهذه الإحاطة، بل إن ما يشغل محمد بن عبد الله الإنسان، من آلام وآمال خاصة لا يرد فيه إلا نادرًا، فأين موت زوجه خديجة في القرآن، وهي كانت حِبَّه وأنسه؟ وأين موت عمه أبي طالب في القرآن وهو كان سنده ونصيره؟
ويتجه الأستاذ مالك إلى علاقة القرآن بالكتب السابقة، فوَصْف القرآن في القرآن أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، أي هو معيار الحق والصواب، والكلمة الخاتمة الباقية، وفي باب العلم بالله ألغى كل شِرك وتعدد وتشبيه، وقرر التوحيد الخالص، وقرر حقيقة الآخرة، وهي فيه مشاهد متحركة ناطقة مفصلة تهز القلوب، وهو يخبرنا عن أولية الخلق، وعن قوانين الأخلاق التي تتجاوز المصلحة الذاتية إلى نظام واسع مبني على الجزاء الدنيوي والأخروي الفردي والجماعي. ويعقد فصلًا للموازنة بين القرآن وما يسمى العهد القديم في قصة يوسف عليه السلام، ويتبين التشابه الواضح في أصل الأحداث، لكن سياق القرآن تغلب عليه الروحانية، ولا سيما في مواقف يعقوب ويوسف وكلامهما، وفي القصة التوراتية بعض معالم الوضع واضحة كركوب الحمير في السفر. وهذا التشابه يفرض السؤال عن مصدر هذه العلوم، فمن أين علم الرسول ﷺ خبرها في أمة أمية، لم يعلموا علم تلك الكتب، ولا ترجمت لذلك العهد إلى العربية، والقرآن يقول: (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا)، ولو كان الواقع غير هذا لما كان لهذا النفي ونحوه معنى، ولردُّوه عليه بأنهم كانوا يعلمون. ولو سايرنا فرض العلم السابق لكان يجب أن نتصور تعدد المصادر والنسخ والموازنة بينها حتى تخرج الرواية الجديدة بتميزها واتساقها.
وقد كانت نجوم القرآن جزءًا من نظام ونسق موافق لما سيتلو التنزل الأول من سور وآيات في ثلاثة وعشرين عامًا، بل له امتداد في الزمن حتى الآن، ولا تفهم إلا على أنها صادرة عن علم محيط بالمستقبل. وفي القرآن يمتزج الغيب بالشهادة، والتذكير بالمعلوم بالإخبار بالمجهول، وهذه المقادير من الغيوب والمجاهيل من خلق الكون والمستقبل والسنن لا تكون تفكيرًا بشريًّا محصورًا فيما يرى ومقيدًا بما يعلم وأسيرًا لنوع من المشاهدات والمألوفات. وبعض ما أخبر به ينكشف للإنسان يومًا بعد يوم. والصورة في القرآن ليست دائما ملائمة لحياة الجزيرة وما فيها من جبال وحيوان ونبات، بل نرى فيه أشياء بعيدة عنها، كالأنهار والمروج وظلمات البحار وموجها كالجبال.
(9) هذه زبدة كتاب الظاهرة القرآنية، وفي المقدمة التي كتبها الأستاذ شاكر له (كان ذلك سنة 1378ه = 1958م) يوافق المؤلف على ما ذكر من أثر الاستشراق في عقول المسلمين وخطره وضرره، ويخالفه في قضية الإعجاز، ومن رأيه أن التحدي بالقرآن كان بلفظه ونظمه لا بشيء خارج عن ذلك، وأن العرب طولبوا بأن يعرفوا دليل النبوة بمجرد سماع القرآن، كما قال الله: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)، فالقرآن برهان على صحة النبوة، وليس صحة النبوة برهانًا على إعجاز القرآن، ومنهج الأستاذ مالك عُني بإثبات صحة دليل النبوة، وليس هذا هو إعجاز القرآن، وقضية الإعجاز أعقد من أن يعانيها العقل الحديث في رأيه، وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعر الجاهلي. ولما قرأ النبي ﷺ القرآن على قومه طالبهم أن يؤمنوا بما دعاهم إليه بدليل واحد هو ما يتلوه عليهم، وبذلك يكون قليل القرآن وكثيره في الإعجاز سواء، ويكون ما فيه من الغيوب والأخبار والشرائع بمعزل عما طولبوا به من الاستدلال ببيانه على أنه من عند الله، فإذا علموا ذلك طولبوا بالإقرار بصحة ما جاء فيه، وليس العكس. ولا معنى لذلك فيما يرى الأستاذ شاكر إلا أن يكونوا قادرين على التمييز بين ما هو من كلام البشر وما ليس من كلامهم، وأن تكون لغتهم قادرة على احتمال هذا الفرق الهائل بين الكلامين، وأن يكونوا في البيان عن أنفسهم بلغوا مبلغًا عظيمًا، وذلك يفضي إلى التماس ما بقي من كلامهم شاهدًا على كل ما سلف، وهو الشعر الجاهلي. (عاد إلى هذا المعنى في قضية الشعر الجاهلي 94-96 كما سيأتي).
ويقول الأستاذ شاكر إنه محَّص ما محص من الشعر الجاهلي فوجده يحمل في نفسه أدلة صحته وثبوته، بما فيه من قدرة خارقة على البيان، وأنه منفرد في آداب العرب وسائر الأمم. وإذا صح ذلك وجب أن يدرس هذا الشعر لالتماس قدرة البيان التي يمتاز بها، فإذا تم ذلك كان من الممكن أن يُلتمس هذا الذي أعجزهم في القرآن، ويرى أنه سيكون ذلك فتحًا لا في تاريخ البلاغة العربية، بل في بلاغة البشر، وسيكون مَقنَعًا للعقل الحديث الذي يتطلب معرفة إعجاز القرآن، وسيكون ذلك وسيلة إلى الدعوة إلى كتاب الله. وهكذا يجعل الأستاذ شاكر معنى الإعجاز في العصر الحاضر شيئًا مؤجلًا. (أشار إلى نحو من هذا المعنى في مقدمته لكتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة).
واقتص الأستاذ شاكر قصة ظهور الجدل في القرآن مختصرة والقول بالصرفة، حتى ألف الباقلاني (-403هـ) كتابه في إعجاز القرآن، وأحسن فيه ما كتب الله له، ولما كان يردُّ على الملحدين الذين خاضوا في القرآن ووزانوا بينه وبين الأشعار، دعاه ذلك إلى أن تناول قصيدة لامرئ القيس وجعل يضَعِّفها، ويعلي من شأن بيان القرآن، ويرى الأستاذ شاكر أن العلماء بعده أخذوا هذا المأخذ، وبقي الشعر الجاهلي مع ذلك مثقِّف الألسنة والشاهد على اللغة، فإذا جاءوا إلى الإعجاز اتخذوا الشعر هدفًا، ثم أدخل الناس عليه بابًا آخر من الحيف، وهو الموازنة بينه وبين شعر المحدثين، فكان ذلك مع ما لحقه من الضياع واختلال الرواية واختلاط المعاني غاشيةً حجبت حقيقته وسهلت معابته، حتى أفضينا في هذا العصر الحديث بعد الاستعمار إلى اختلاف المناهج وضعف العربية والزراية على التراث كله.
(10) ثم كتب الأستاذ شاكر فصلًا آخر في قضية الشعر الجاهلي وإعجاز القرآن في محاضرة ألقاها في الرياض سنة 1396هـ = 1975م، ونشرتها في حينها مجلة العرب في جزأين في عددِ آخِر السنة والذي يليه، غير أنهم حذفوا منها المقدمة الطويلة في أنه غير قادر على المحاضرة الشفوية، وعن معنى المنهج والدراسة الأدبية عنده، وذلك نحو خمس صفحات من المطبوع في المجموع المعنون: "قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام" سنة 1418هـ = 1997م (وصححه الدكتور الطناحي، رحمه الله)، يقابلها في التسجيل الصوتي نحو ثلث ساعة، والكلام فيها في ثلاثة معان: (1) عمر الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا وأولية الشعر، (2) وما انتهى إلينا من شعر الشعراء المعروفين، (3) ووضْعُ الشعر ونَحْلُه أهل الجاهلية، فأما الأمر الأول فخلاصته أن الجاحظ قرر في الحيوان (1/74) أن الشعر حديث الميلاد مستدلًّا ببعض الأعلام في شعر امرئ القيس، قال: "فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام"، ويرى الأستاذ شاكر أن هذا الحساب لا ينفع إلا في أن امرأ القيس وخاله مهلهلًا من أقدم شعراء الجاهلية الذين بلغنا شعرهم، فشعر سائر الشعراء الذين انتهى إلينا شعرهم لا يجاوز مائتي سنة، يقول: "وهذا يوشك أن يكون حقًّا لا ريب فيه" مقيَّدًا بـ "القصائد المقصَّدة دون ما نسميه المقطَّعات" (ص 14)، ويخالفه في أن هذا هو أول الشعر، أي إن الشعر أقدم من ذلك، ولكن هذا أقدم ما بلغنا. وابن سلام يقول: "لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما قُصِّدت القصائد وطُوِّل الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط شعر عاد وثمود وحِمْير وتُبَّع" (الطبقات 26)، ثم يقول: "وكان أول من قصَّد القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي (الطبقات 39) ... [و] كان امرؤ القيس بن حُجْر بعد مهلهل، ومهلهل خاله" (الطبقات 41). 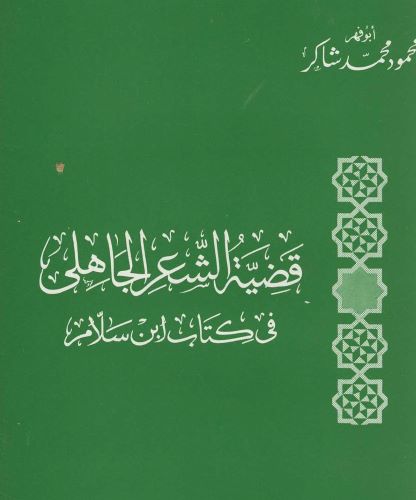
ثم يمضي الأستاذ شاكر في فصل طويل يشرح طليعة كتاب ابن سلام، وهي المقدمة التي ذكر فيها مسائل من نقد الشعر وتاريخ علم العربية بما أنها متصلة برواية الشعر، ويصل معانيها بحياة ابن سلام، ويفسر لِـمَ كانت على هذا النحو في سياقتها وتركيب أجزائها، وانتهى إلى شرح منهجه في التذوق لـمَّا كان استنباطه تلك المعاني مبنيًّا على استنطاق كلام ابن سلام مستضيئًا بشذرات من سيرته، يقول: "فواجبنا اليوم أن نعيد بناء أنفسنا على ما بُنيت عليه حضارتنا من دقة التذوق، وأن يكون التذوق أساس عملنا الأدبي في آثار أسلافنا... وكل بحث أدبي أو تاريخي سوف يكون عندئذ استحياء لأشباح مضت، من رسوم كلمات بقيت" (ص 59)،
ومصطلح التذوق يتردد كثيرًا في كلام الأستاذ شاكر، وقد شرحه في مقالات: "المتنبي ليتني ما عرفته" الثاني والثالث منها (الثقافة 10 و12/1978)، في كلام طويل خلاصته أنه استبانة صفات المتكلم، وصفات الكلام، بما في أجزاء الكلام وأطوائه ( جمهرة المقالات ص 1187)، وضرب مثلًا هنا (قضية الشعر الجاهلي 59-60) بقصة إدخال ذي الرمة أبياتًا في الهجاء لجرير أعانه بها على مهجوه، فلما سمعها الفرزدق علم أنها لجرير (الأغاني -الدار- 18/21)، وعلم المهجوُّ أيضًا أنها لجرير (الأغاني 8/58 وسبق إلى الاستدلال بهذه القصة الخطَّابي في رسالته في إعجاز القرآن في ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 25)، ويصل الأستاذ شاكر هذا بأمر إعجاز القرآن فيقول: إن الله طالَبَ عرب الجاهلية "أن يتبينوا أن ما نزل هو كلام الله المفارق لكلام البشر على اختلاف ألسنتهم، وذلك بمجرد سماعه يتلى عليهم في آيات قلائل في أول العهد بالإسلام، وفوض إليهم أن يحكموا على قليله منذ بعث بأنه وحي أوحاه الله لا يطيق أن يأتي بمثله لا محمد ﷺ ولا غيره من البشر، ولا سبيل لأحد إلا عن طريق التذوق الذي وصفناه لا غير" (ص 60)، ويستشهد كما استشهد من قبل في مقدمة الظاهرة القرآنية بحديث الصحيحين: "ما من الأنبياء نبي إلا أُعطِيَ ما مِثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة"، أي هو الآية التي طولب البشر جميعًا أن يستدلوا بها على صحة النبوة، ويستشهد على أثر التذوق في المعرفة بحديث صحيح مسلم لما سمع ضِمَاد الأزدي قول النبي ﷺ: "إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال: فقال: أعد عليَّ كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله ﷺ ثلاث مرات، قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر (كذا عند مسلم، وكأن الصواب: قاموس، كما في سائر الروايات)، قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام".
ويشرح الأستاذ شاكر صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن بأبسط مما سلف في مقدمة الظاهرة القرآنية، وذلك في سياق التعليق على قول ابن سلام: "فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته، فما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يئولوا إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، فألْفَوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب عليهم منهم كثير" (الطبقات 25)، ومن رأي الأستاذ شاكر أنهم لم يلهوا عن رواية الشعر، لأنهم لم يلهوا عنه في صدر النبوة، ولكن قلَّت الرواية من جراء الموت والقتل والغزو، ثم اتسعوا من بعد فيها (ص 92 و93)، وهذا عين ما قاله ابن سلام، لأن لهوهم عنها ليس معناته أن كلهم تركها، فآل الأمر إلى معنى القلة والكثرة، ويقول الأستاذ شاكر: إنه مع أن الأبناء تطلَّبوا أخبار الآباء وأشعارهم كان الأمر أجلَّ من ذلك، لأن الله أمر العرب أن يميزوا بين بيان البشر وبيان القرآن ليستدلوا على أنه من عند الله، وتحداهم أن يأتوا بمثله، أو عشر سور مثله، أو سورة مثله، أو سورة من مثله، وفوض إليهم الحكم في ذلك، وهذا يدل على أنهم قادرون على الحكم، مؤتمنون عليه (وقضية أنهم مؤتمنون غير صحيحة، لأن الكافرين منهم وصفوه بالشعر والسحر وأساطير الأولين وقول البشر، وزعموا أنهم لو شاءوا لقالوا مثله، ولكنهم لم يفعلوا)، وقدرتهم على ذلك هي المقدار من التذوق الذي يفصل بين كلام وكلام، وهي قدرة قديمة، ولها أمثلة حية متداولة، وهذه حقيقة لا يجوز إسقاطها من الدراسة الأدبية، ولم يكن إسقاطها إلا تقليدًا لغير العرب والمسلمين ممن درسوا هذا التراث في حالة من ضعف العرب والمسلمين (ص 94-96)، ذلك أن نزول القرآن حادثة فريدة في تاريخ البشر، لم يكن لها شبيه ولن يكون، فعَزْلُـها عن الدراسة الأدبية والتاريخية لا يكون إلا ممن لا يؤمنون بأنه كلام الله، أو العاجزين عن فهم التاريخ (ص 102-103)، يقول: "وإذن فلم يكن نزول القرآن العظيم داعيًا إلى هجر شعر الجاهلية، بل كان حافزًا مثبِّتًا لهذا الشعر في النفوس بتكرار التذوق والتأمل" (ص 113)، و"هل يمكن أن يتصور امرؤ... أن يعمد صحابي أو تابعي في حاضرة أو بادية إلى وضع شعر على لسان امرئ القيس أو طرفة أو أبي دؤاد الإيادي... إلا أن يكون هذا المرء هازلًا هزلًا لا خير فيه أو لا عقل فيه إن شئت؟... فهل تظنه سهلًا على أحد أن يفضح نفسه بافتعال شعر ينسبه إلى جاهلي قديم، وفي الناس من هو قادر على تكذيبه والنكير عليه؟" (ص 120-121).
(11)
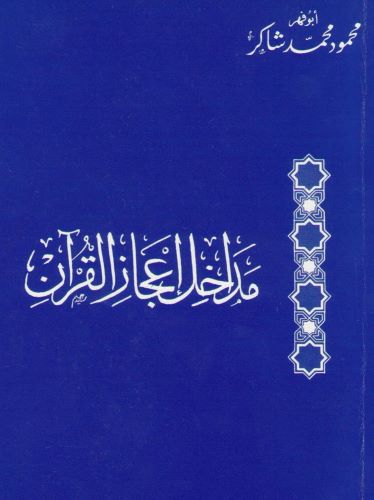 كان لا بد مما سلف لنفهم أطوار الرأي فيما فصَّله الأستاذ شاكر في معنى الإعجاز، وموقعه في بحث القضية، وقد أخذت زبدة ما قال على صعوبة ذلك، لأنه يطنب إطنابًا شديدًا، ويكرر المعنى مرارًا، ويمعن في الخطابة، ويطيل الحديث عن النفس، ويكون المقصود والمهم في جمل قلائل تأتي في الفلتات في أطواء الكلام. كان لا بد مما سلف لنفهم أطوار الرأي فيما فصَّله الأستاذ شاكر في معنى الإعجاز، وموقعه في بحث القضية، وقد أخذت زبدة ما قال على صعوبة ذلك، لأنه يطنب إطنابًا شديدًا، ويكرر المعنى مرارًا، ويمعن في الخطابة، ويطيل الحديث عن النفس، ويكون المقصود والمهم في جمل قلائل تأتي في الفلتات في أطواء الكلام.
ثم كتب الأستاذ فصلًا ثالثًا في المعنى في السنة التي كتب فيها "قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام"، أي سنة 1396هـ = 1975م، ونُشر بأخَرَة سنة 1423هـ = 2002م بعنوان "مداخل إعجاز القرآن"، وجزء منه منشور الآن مسجلًّا بصوته، وهو المدخل الأول، لأن الثاني هو مقدمة الظاهرة القرآنية، والثالث نشر مستقلًّا بعنوان: "قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام".
وبعد الخطابة المعهودة يشرح ألفاظ الإعجاز والمعجزة والتحدي في اللغة، ويقرر أنها بمعانيها الاصطلاحية من الألفاظ المحدثة، ظهرت في المائة الثالثة، وانتشرت في التي بعدها، وأن أسبقها ظهورًا لفظ التحدي، وأن أقدم ما جاء من استعمال التحدي في كلام الجاحظ (150-255هـ) في رسالته "حجج النبوة". ويتبين الأستاذ شاكر أنه مع دوران لفظ العجز والتحدي في كلام الجاحظ لم يرد فيه لفظ الإعجاز، وله كتاب في هذا المعنى مفقود سماه: نظم القرآن.
وههنا استطراد مني، وهو أن لفظ المعجز والمعجزة جاء في كتب جابر بن حيان (مختار رسائل جابر بن حيان -الخانجي- 491)، وهو يُنسب في الشائع إلى المائة الثانية (انظر ترجمته في الفهرست -أيمن فؤاد- 2/451، والوافي بالوفيات -جمعية المستشرقين- 11/34)، وهذا مما يقوي الشك في حقيقة جابر هذا، ليس من قبل وجوده، ولكن من قبل الزمن الذي عاش فيه، وأنا أميل الآن إلى أنه من المائة الثالثة، وأفترض أن هذا الاسم مستعار، وأن المؤلف لهذه الكتب والرسائل ليس من الضروري أن يكون واحدًا، فقد يكون جماعة كإخوان الصفا (وانظر ما كتبه الأستاذ فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي 4/196-395 وهو بحث طويل دافع فيه عن نسبة جابر بن حيان إلى المائة الثانية).
ثم يرى الأستاذ شاكر أن لفظ العجز غير ملائم للمعنى المراد في أن القرآن آية على النبوة، لأن العجز أن يحاول المرء فعل شيء ثم لا يجد في نفسه قدرة عليه، وآيات الأنبياء لم يكن فيها هذا المعنى، لأنها غير داخلة في قدرة البشر، كإحياء الموتى، فهم لا يحاولونها أصلًا، فلا يليق هنا لفظ العجز، ويختار بدلًا منه لفظ الإبلاس (ص 44-47)، وهذا تحكم من الأستاذ، فإن العجز يأتي في معنى القصور بعد المحاولة، كما حديث الصحيحين في صلاة التراويح: "خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها"، ويأتي في معنى عدم القدرة أصلًا، وفي القرآن الكريم: (أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب)، وهو لم يحاول ذلك، كأنه قال: ألم تكن لي قدرة على مثل فعل الغراب؟ وفي حديث صحيح مسلم: "كل شيء بقَدَر حتى العَجْز والكَيْس"، ويأتي ضدًّا للحزم والهم، وفي حديث صحيح مسلم: "استعن بالله ولا تعجز"، أي لا تضعف، وليكن لك همة ونهضة إلى ما تريد، وفي حديث البخاري: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة"، وقال زهير:
مورَّثُ المجد لا يغتال همتَه * عن الرياسة لا عجزٌ ولا سأَمُ وقال الحماسي: متى ما يرى الناسُ الغنيَّ وجارُه * فقيرٌ، يقولوا: عاجزٌ وجليدُ فإذا دخلت عليه همزة التعدية وقيل: أعجزه، جرت فيه المعاني الثلاثة، فمعنى: هذا الشيء يُعجزه: لا قدرة له عليه، أو لا تسمو إليه همته، أو يحاوله فيضعف عنه. وأكثر ما جاء في القرآن من الرباعي، نحو: (وما أنتم بمعجزين)، (فإنهم لا يُعجزون)، أي: هو قادر عليهم، فهو من المعنى الأول منفيًّا، وقولهم: إعجاز القرآن من هذا.
وقد هوَّل الأستاذ فجعل أبا إسحاق النظَّام وأبا عثمان الجاحظ قد علما بهذا المغمز في قولهم: مدار الآية على عجز الخليقة، وتواطآ على كتمانه، لأن العجز لا يكون إلا بعد المحاولة! (ص 47-51)، وأن هذا هو الذي أدى إلى القول بالصرفة! (ص 56-57)، لأن آيات الأنبياء الأخرى يأخذ فيها الناسَ الإبلاس، كما يقول، وأما القرآن فكان مقتضى الأمر أن يحاولوا المعارضة، فلما لم يحاولوا كانوا مصروفين عنها! ولما كان هذا يؤدي إلى أن يُسلب نظم القرآن وبيانه كل فضيلة، ألف الجاحظ كتابه الاحتجاج لنظم القرآن، وهو مفقود (ص 64).
وتنبه الأستاذ شاكر على كلمات تتردد في كلام الجاحظ على القرآن، من نحو قوله: "لأن رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة، طويلة أو قصيرة، لتبين له في نظامها ومخرجها، وفي لفظها وطبعها، أنه عاجز عن مثلها" (رسائل الجاحظ 3/229 رسالة حجج النبوة)، وهي النظم والمخرج والطبع، قال الأستاذ شاكر: "وحسب أبي عثمان فضيلة وفضلًا أنه هو الذي افتتح هذا الباب بألفاظه البارعة القوية الإيحاء، وبثها في سياق تركيب كلامه... فمهَّد لمن بعده أن يتناول القضية تناولًا يعينه على أن يصوغها صياغة قابلة للإثبات" (ص 76)، ولاحظ أنه لم يذكر لفظ البلاغة في وصف القرآن كما كان يذكره في وصف غيره من الكلام، وذكرها الرماني (296-386هـ) على أنها وجه من وجوه الإعجاز، وعرَّفها ثم ذكر أقسامها عنده، فانضم في رأي شاكر لفظ البلاغة إلى ألفاظ الإعجاز والمعجزة والتحدي والعجز، وكان لفظ البلاغة لذلك العهد غير واضح المعالم معوَّلًا فيه على التذوق.
ثم نقل عن معاصر الرماني أبي سليمان الخطَّابي (319-388هـ) ما في صدر رسالته من تصوير حيرة الناس في معنى الإعجاز، وذلك قوله: "قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديمًا وحديثًا، وذهبوا فيه كل مذهب من القول، وما وجدناهم بعدُ صدروا عن رِيٍّ، وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن" (ثلاث رسائل 21)، ولما ذكر البلاغة -وقد صار لفظًا مألوفًا ذكره في هذا الباب- قال: "وفي كيفيتها يعرض لهم الإشكال، ويصعب عليهم منه الانفصال، ووجدت عامة أهل هذه المقالة في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد، وضرب من غلبة الظن، دون التحقيق له، وإحاطة العلم به، ولذلك إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن... قالوا: إنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن لغيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربًا من المعرفة لا يمكن تحديده... وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع، وهشاشة في النفس، لا توجد مثلها لغيره منه، والكلامان معًا فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة، وهذا لايقنع في مثل هذا العلم، ولا يشفي من داء الجهل به، وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام" (ثلاث رسائل 24-25). وفي رأي شاكر أنه لم يزد على أن صوَّر غموض الأمر والحيرة فيه، ثم تابع الناسَ فيما قالوه في معنى البلاغة. وأما الباقلاني (338-403هـ) فسلف كلام الأستاذ على كتابه في مقدمة الظاهرة القرآنية. وفيه مع ذلك مباحث في البيان -وهو البلاغة على مصطلح المتأخرين- مهمة، ومناقشات جليلة، وأمثلة كثيرة، وبيان ناصع، وفكر ثاقب.
ثم ذكر الأستاذ هنا رأي القاضي عبد الجبار (-415هـ) في كتابه المغني، قال: "وقد سلك قاضي القضاة عبد الجبار سبيل من سبقه من المتكلمين في الإعجاز، ولكنه في خلال ذلك أراد أن يزيل الإبهام عن معنى الفصاحة والبلاغة، ويفعل ما لم يفعله أحد قبله ممن كتب في إعجاز القرآن، وكان سبيله إلى ذلك مجرد النظر على أسلوب المتكلمين... ولكن هذه المحاولة في كشف الإبهام والتي تجاوزها القاضي الباقلاني سوف يكون لها أثر عظيم في تاريخ اللغات والألسنة"، وهو يعني ما جاء به عبد القاهر الجرجاني (-471هـ) في "دلائل الإعجاز" ناقضًا لآراء القاضي، وهو ما بينه شاكر مفصَّلًا من بعد في صدر نشرته من الدلائل سنة 1404ه = 1984م، وذكر هنا أن كلام عبد القاهر يدل على أنه أحاط بكلام من سبقه، وأنه شغله تحديد معنى البلاغة والفصاحة، ذلك أنه يقول: "ولم أزل مذ خدمت العلم أنظر في معنى الفصاحة والبلاغة، والبيان والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء، والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على المكان الخبيء ليطلب، وموضع الدفين ليبحث عنه فيُخرج، وكما يُفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه، وتُوضع لك القاعدة لتبني عليها، ووجدت المعوَّل عليه أن ههنا نظمًا وترتيبًا، وتأليفًا وتركيبًا، وصياغة وتصويرًا، ونسجًا وتحبيرًا..." (دلائل الإعجاز -شاكر- 34)، ثم قال: "وإذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسًا ما، وأن تصفها وصفًا مجملًا، وتقول فيها قولًا مرسلًا، بل لا تكون من معرفتها في شيء، حتى تفصِّل القول وتحصِّل، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلام، وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئًا شيئًا" (الدلائل 37).
ويرى الأستاذ شاكر أن عبد القاهر كان مأخوذًا بألفاظ الجاحظ البارعة ومن بعده الباقلاني في وصف بيان القرآن، وكانت كالإيماء والرمز إلى حقيقة ذلك، فأجهد نفسه في الكشف عن معانيها، بما كان له من علم بالعربية، ومن تذوق للبيان، لا بل إن عبد القاهر دل على هذا المعنى بنفسه، وأرشد إليه بلفظه، فقال: "وإن الذي قاله العلماء والبلغاء في صفتها والإخبار عنها (أي البلاغة)، رموز لا يفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع، ومن هو مهيأ لفهم تلك الإشارات... وليت شعري من أين لمن لم يتعب في هذا الشأن ولم يمارسه ولم يوفر عنايته عليه - أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يذكر عجاز القرآن: ولو أن رجلًا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة، لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها، أنه عاجز من مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها" (الدلائل 250-251، وكلام الجاحظ في الرسائل 3/229 رسالة حجج النبوة).
ومن أجل ذلك ألف كتابيه: "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" فأسس بذلك علمًا لم يسبق إليه (ص 96)، فشرح وجوه البديع -وهو البيان على مصطلح المتأخرين- في "أسرار البلاغة"، وهي راجعة إلى المعاني لا إلى الألفاظ، وشرح وجوه النظم والتأليف، وهي راجعة إلى معاني النحو في "دلائل الإعجاز"، وهو كما هو ظاهر من عنوانه ومن طلائعه وأطوائه وخواتيمه كتاب في تفسير الإعجاز أفضى به إلى أن كان أصلًا في علم البلاغة، وإلى أن اشتق من علم النحو علمًا آخر أصَّله وفصَّله، وصار فيه إمامًا لمن جاء بعده. وقال في مدخل كتابه -كما استشهد الأستاذ شاكر-: "فما جوابنا لخصم يقول لنا: إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق التي هي محصول النظم موجودة على حقائقها، وعلى الصحة وكما ينبغي في منثور كلام العرب ومنظومه... فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، وباهر الفضل، والعجيب من الرصف، حتى أعجز الخلق قاطبة؟... فإن كان ذلك يلزمنا فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه..." (الدلائل 8-9)، ونقل أيضًا من خواتيم الكتاب قوله: "ما أظن بك -أيها القارئ لكتابنا- إن كنت وفيته حقه من النظر، وتدبرته حق التدبر، إلا أنك قد علمت علمًا أبى أن يكون للشك فيه نصيب، وللتوقف نحوك مذهب، أن ليس النظم شيئا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم... ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه... غارٌّ نفسه بالكاذب من الطمع، ومسْلم لها إلى الخُدَع، وأنه إن أبى أن يكون فيها، كان قد أبى أن يكون القرآن معجزًا بنظمه، ولزمه أن يثبت شيئًا آخر يكون معجزًا به، وأن يلحق بأصحاب الصَّرْفة، فيدفع الإعجاز من أصله" (الدلائل 525-526).
ولا بد هنا قبل مواصلة تبين رأي الأستاذ شاكر في ما انتهى إليه الشيخ عبد القاهر وموقعه من فهم إعجاز القرآن من التذكير أو التنبيه على الفرق بين قول القاضي عبد الجبار وقول عبد القاهر، بما أنه كان مما بعث عبد القاهر على تأليف كتابه وشرْح نظره في معنى الإعجاز ونظم القرآن، وأن القاضي كان استفاد معنى النظم على سبيل الإجمال من إمام آخر من أئمة الاعتزال، وهو الجاحظ، ذلك أن القاضي قال في كتابه المغني 16/199 بعد فصول مهمة في ثبوت القرآن وكينونته برهان النبوة والتحدي به: "فصل في الوجه الذي يقع له التفاضل في فصاحة الكلام. اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في الصفة أن تكون (1) بالمواضعة التي تتناول الضم، (2) وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه، (3) وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع، لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاتها أو موقعها، ولا بد من هذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض. فإن قال: فقد قلتم في أن جملة ما يدخل في الفصاحة حسن المعنى، فهلَّا اعتبرتموه؟ قيل له: إن المعاني وإن كان لا بد منها فلا تظهر فيها المزية، وإن كان تظهر في الكلام لأجلها، ولذلك تجد المعبرين عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآخر والمعنى متفق، وقد يكون أحد المعنيين أحسن وأوقع والمعبِّر عنه في الفصاحة أدون، فهو لا بد من اعتباره، وإن كانت المزية تظهر بغيره، على أنا نعلم أن المعاني لا يقع فيها تزايد، فإذًا يجب أن يكون الذي يُعتبر التزايدَ عند الألفاظ التي يعبر بها عنها..." في تفصيل طويل هو إلى النظر العقلي أقرب منه إلى تذوق اللغة.
وكان مما رد به عليه عبد القاهر -ويكاد يكون الكتاب في هذا المعنى- أن قال: "فقد بان وظهر أن المتعاطي القول في النظم، والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه، وهو لا يعرض فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التي قدمنا ذكرها، ولا يسلك إليه المسالك التي نهجناها، في عمياء من أمره، وفي غرور من نفسه، وفي خداع من الأماني والأضاليل، ذاك لأنه إذا كان لا يكون النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية في النظم، ثم لا يطلبها في معاني النحو وأحكامه التي النظم عبارة عن توخيها فيما بين الكلم" (الدلائل 392-393).
فالفرق بينهما أن تعويل القاضي على النظم ساذجًا خلوًا من معاني النحو المفصلة، وهي المعاني التي يُنظم بها الكلام على الفروق الكثيرة التي بَيْنها مما شرحه عبد القاهر في كتابه، ممزوجةً بالمعاني الأخرى من الاستعارات ونحوها، دالةً على المعاني العامة التي وراءها، فرجع الأمر إلى نظم الألفاظ مشتبكًا بدرجات المعاني، وهو ما بيَّنه عبد القاهر أيضًا من الفرق بين المعنى ومعنى المعنى (الدلائل 263). فالقاضي يجعل المزية لفظية، وعبد القاهر يجعلها لفظية معنوية يختلطان ولا ينفصلان.
ثم نرجع إلى سياقة شرح الأستاذ شاكر، فإنه قد رأى أن عبد القاهر وضع يده على ما رآه سببًا للتفاضل في المزايا البيانية، ولكنه لم يبين حدود الدرجات والمراتب، أي دلنا على العلة، ولم يدلنا على كيفية أن تكون هذه العلة مفضية إلى أن يخرج الكلام عن طوق البشر، أي إلى أن يكون معجزًا، ذلك أنه قال: "... كذلك يفضُل بعض الكلام بعضًا، ويتقدم منه الشيءُ الشيءَ، ثم يزداد فضله ذلك، ويترقَّى منزلة فوق منزلة، ويعلو مرقَبًا بعد مرقب، ويُستأنف له غاية بعد غاية، حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع، وتحسِر الظنون، وتسقط القوى، وتستوى الأقدام في العجز" (الدلائل 35)، وقال شاكر: "لم يحدَّ لنا عبد القاهر هذا الحد، ولا من أين يبدأ هذا الافتراق بين الكلام المتفاوت درجة بعد درجة، وبين الكلام الذي تنقطع دونه الأطماع، وتحسُر الظنون، وتسقط القوى، وتستوى الأقدام في العجز؟ فإنما هذه صفات ونعوت لما في نفسه من التذوق لهذا القرآن العظيم، لا تبعد كثيرًا عن نعوت تذوق الإمامين الجليلين أبي عثمان الجاحظ وأبي بكر الباقلاني" (ص 114)، ثم يتبين الأستاذ شاكر أيضًا أن عبد القاهر أخذ ألفاظ الجاحظ في التعبير عن تذوقه للقرآن وترك لفظين شديدي الغموض حافلين بالإيحاء، كما يقول (ص 115)، في صفة بلاغة القرآن، وهما: "طبعه ومخرجه" (رسائل الجاحظ 3/229 رسالة حجج النبوة)، يقول: "فهذه المرتبة المنقطعة وحدها بعد البلاغة التي كشف إبهامها بكتابيه مرتبة مستورة بالإبهام، لعلها كانت قائمة في نفسه، ولكنه لم يطق الإبانة عنها" (ص 117)، ثم أصاب الشيخ شاكر الحسور أيضًا والانقطاع، فقال: "وحسبي أنا فيما أظن ما قلته آنفًا، فإن الأمر أوسع سعة، وأعمق عمقًا، وأبعد منالًا، من قدرة هذا الجهد الذي بذلته، وهو محتاج إلى تفصيل لا يتحمله مثل هذا المدخل... فعسى أن يأتي يوم يأذن الله فيه بأن ينشأ منا أو من أعقابنا من يتمم عمل عبد القاهر، ويكشف ما عجز عن بيانه وتفسيره في شأن طبع القرآن ومخرجه ومخرج آياته، ويومئذ يتغير القول في مسألة إعجاز القرآن تغيرًا يخرجنا من هذه البلبلة التي استمر إبهامها قرونًا طويلة" (ص 117-119)، واستأنف بعد هذا فصلًا تشعب فيه القول، وانقطع الكلام عن غايته، وقال الناشر للكتاب: "إلى هنا انتهى ما وصل إلينا من أصول المدخل الأول كما كتبها الأستاذ شاكر -رحمه الله- بخطه ولم يكمله" ( ص 140).
(12)
 وهكذا ترى أنه انتهى أمر الشيخ عبد القاهر إلى الانقطاع، وأمر الشيخ شاكر كذلك، وبقي في الأمر كثير من الاستبهام والبلبلة المستمرة منذ قرون، كما يقول. وإذا كان شأن الإعجاز متروكًا لاجتهاد الناس وبحثهم ونظرهم، ولم يبلغوا منه حتى الآن مَقنعًا، ولا صدروا منه عن رِيّ، فليس هو إذًا الإعجاز الأول الذي تحدى به القرآن العرب، لأن التحدي والعجز والإعجاز كان من أول الأمر، وقامت به الحجة، ووقع به الإفحام، وكان بقليل القرآن وكثيره، وبذلك يجب أن نفهم أن إعجاز القرآن وجوه كثيرة، وأن إعجاز البيان منه وجوه كثيرة، يجري أمرها على نحو كل علوم القرآن يكشف الزمن منها شيئًا فشيئًا، ويبلغ الناس من أمرها ما يفتح الله به، ويؤوِّل القرآنَ الزمن، كما قال الله تعالى: (بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله)، حتى تكون القيامة تأويلًا له، لأنه قص وقائعها وما يكون فيها، فستأتي على نحو ما أخبرنا، كما قال الله تعالى: (هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق). وهكذا ترى أنه انتهى أمر الشيخ عبد القاهر إلى الانقطاع، وأمر الشيخ شاكر كذلك، وبقي في الأمر كثير من الاستبهام والبلبلة المستمرة منذ قرون، كما يقول. وإذا كان شأن الإعجاز متروكًا لاجتهاد الناس وبحثهم ونظرهم، ولم يبلغوا منه حتى الآن مَقنعًا، ولا صدروا منه عن رِيّ، فليس هو إذًا الإعجاز الأول الذي تحدى به القرآن العرب، لأن التحدي والعجز والإعجاز كان من أول الأمر، وقامت به الحجة، ووقع به الإفحام، وكان بقليل القرآن وكثيره، وبذلك يجب أن نفهم أن إعجاز القرآن وجوه كثيرة، وأن إعجاز البيان منه وجوه كثيرة، يجري أمرها على نحو كل علوم القرآن يكشف الزمن منها شيئًا فشيئًا، ويبلغ الناس من أمرها ما يفتح الله به، ويؤوِّل القرآنَ الزمن، كما قال الله تعالى: (بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله)، حتى تكون القيامة تأويلًا له، لأنه قص وقائعها وما يكون فيها، فستأتي على نحو ما أخبرنا، كما قال الله تعالى: (هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق).
وإذًا فتصوير الأمر على هذا النحو صحيح من هذه الجهة، وذلك أنه بقيت من علوم القرآن ومنها الإعجاز غايات وراء غايات، وآيات بعدها آيات، ولكن قدرًا منه وقع من أول يوم، وبالنجوم القليلة التي نزلت، والسور الأُوَل التي تليت، فسمعها من سمعها، وآمن عليها من آمن، وكفر بها من كفر، وظهر بها أن القرآن آية النبوة التي لا ريب فيها، دالة على أنها من عند الله، وأن القرآن لا يكون قول البشر، ولا يجوز أن يكون للبشر قدرة عليه، وهو ما أشرت إليه أولُ من أنه لا يستمد من خزانة تعبير العرب الذين عاشوا في ذلك الزمن، وهم العرب يومئذ أصحاب اللسان، ولا ناطق به غيرهم، فأين تجد في كلامهم تركيب: (رب العالمين) أو اشتقاق: (المتقين) أو (المفلحون)، وأين تجد مثَل اشتراء الضلالة بالهدى، أو مثل الذي استوقد نارًا، أو مثل الصيب من السماء، بل أين تجد: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وامض في القرآن أين شئت، وتتبع ما فيه من مفردات ومركبات وأمثال ممزوجة بالمعاني الجليلة، والأخبار العجيبة، والأحكام الجازمة، والأوامر العلوية، مقرونة بجدة النمط الذي ليس شعرًا ولا نثرًا ولا سجعًا ولا خطابة، جارية فوق ذلك على قوانين لسان العرب، يعقلونه ويتذوقونه، وبذلك أسلم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بسماع سورة طه، وأسلم جبير بن مطعم -رضي الله عنه- بسماع سورة والطور، وأسلم السابقون الأولون بالسور القليلة، والآيات اليسيرة، وسمع عتبة بن ربيعة من سورة حم فصلت، وسمع الوليد بن المغيرة من سورة النحل، فقالا ما قالا.
لكني لا أدع كلام الأستاذ شاكر حتى أبين شيئًا، وهو أن ما انتهى إليه من انقطاع البحث في الإعجاز، وبقاء الاستبهام، ومن حيرة القرون الطويلة، ليس كما تصوره على الحقيقة، فقد كان الأمر منه على مد اليد، ذلك أنه شرع في فصل من كلامه ذكر فيه وجوب التفريق في المترادف، والتأريخ للألفاظ، تمهيدًا للفرق بين المعجزة والآية، وقال: "لا بد من الحذر من أمرين عظيمي الخطر على العقل والفهم والنظر، فكلاهما مطية الضلال عن الحق، لا بد من ترك الاستهانة بالفروق البينة والخفية بين الألفاظ التي نتوهم بطول الإلف أنها تقع على معنى واحد وقوعًا واحدًا، وهو ما نسميه في اللغة المترادف، ولا بد أيضًا من الإقلاع عن إهمال تاريخ بعض هذه الألفاظ المترادفة في أوهامنا، ثم التمسك بالحرص على متابعة البحث عن نشأتها: متى نشأت؟ ولم نشأت؟ وكيف نشأت؟" (ص 123)، ثم ذكر التقارب بين لفظ "الآية" ولفظ "المعجزة"، وهما ليسا مترادفين، وكان الاستعمال الأول للآية والآيات في دلائل النبوة، ثم جاء لفظ المعجزة والمعجزات في المائة الرابعة، حتى غلب لفظ "المعجزة" لفظ "الآية"، وغاب استعمال لفظ "الآية"، ثم ذهب يعدد الوجوه التي يأتي عليها لفظ الآية، وكلها تدور على معنى الأمارة والعلامة الدالة، ويقول: إنه لم يجد في كلام أهل الجاهلية استعمال: "آيات الأنبياء" (ص 124-131).
ومن الواضح أن استعمال الآية والآيات في معنى دلائل النبوة هو من مبتكرات القرآن، ثم استعمالها في القطعة المختومة بالفاصلة من القرآن هو مبتكرات القرآن أيضًا، فإذًا تكون الآية والآيات في القرآن بمعنى دلائل النبوة هو ما اصطلح على تسميته العلماء من بعد المعجزة والمعجزات للأنبياء، ومنه جاء مصطلح: "إعجاز القرآن".
لم يَبْنِ الأستاذ فيما بقي من كلامه على هذا التفريق شيئًا، لكن ما أردته هو شيء أدق من هذا وأغمض، وإنما هذا مثال في لفظ واحد، وأنت إذا تأملت كتاب الشيخ عبد القاهر في دلائل إعجاز القرآن وجدته يكاد يكون كله مبنيًّا على الفروق في التراكيب والأساليب والأدوات، وقد بيَّن ذلك بيانًا، وأوضحه إيضاحًا، وفيه ثلاثة مواضع بينة الدلالة على مكان الفروق من الإعجاز، وسأبين ما يمكن أن يستخرج من ذلك.
1- قال: "وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازديادًا بعدها، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض" ( الدلائل 87).
2- وقال أيضًا: "لا يثبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر، وتقصر قوى نظرهم عنها، ومعلومات ليس في متن أفكارهم وخواطرهم أن تقضي بهم إليها، وأن تُطلعهم عليها، وذلك محال فيما كان علمًا باللغة، لأنه يؤدي إلى أن يحدث في دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة، وذلك ما لا يخفى امتناعه على عاقل. واعلم أنا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فتستند إلى اللغة، ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها، وما ينبغي أن يصنع فيها". (الدلائل 249-250).
3- وقال أيضًا: "واعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا يزال يحدث بسببها، وعلى حسَب الأغراض والمعاني التي تقع فيها، دقائق وخفايا لا إلى حد ونهاية، وأنها خفايا تكتم أنفُسَها جهدَها حتى لا يتنبه لأكثرها، ولا يعلم أنها هي، وحتى لا تزال ترى العالم يَعرض له السهو فيه، وحتى إنه ليقصد إلى الصواب فيقع في أثناء كلامه ما يوهم الخطأ، كل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض" (الدلائل 285).
فههنا ثلاث جمل، أحدها أن الفروق كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، وأن المزية ليس في العلم بها ولكن في وضعها مواضعها، وأنه ينشأ من الفروق دقائق وخفايا لا حد لها. فإذا كانت مزية البلاغة في وضع الفروق مواضعها، وكانت الفروق لا حد لها، وكان في استعمالها ووضعها في مواضعها، أي في مقاماتها وأحوالها وسياقاتها الملائمة لها، فمن ذا الذي يطيق مراعاة هذه الفروق التي ليس لها غاية تقف عندها؟ ومن ذا الذي يطلع على الخفايا غير المحدودة ولا يخفى عليه شيء منها، حتى إنك تقدر في كلامه أن تبحث في كل حرف ولفظ وتركيب لِـمَ جاء هنا هكذا، وهنا هكذا؟ ولم كان في سورة كذا هكذا، وفي سورة كذا هكذا؟ ولم قدَّم هذا وأخَّر هذا، ولم حذف هذا وزيد هذا؟ ولم استعمل في هذا الموضع حرف كذا وفي هذا الموضع حرف كذا، والمعنيان متشابهان ومتقاربان؟ ذلك أنا نعلم أنه روعيت هذه الفروق في كلام أهل اللسان الأوائل على نحو ما، ولكنا وجدناهم يتساهلون في ذلك، فينشد الشاعر القافية الواحدة في مقام على خلاف ما أنشدها في مقام، ويأتي الراوية فيبدل لفظًا بلفظ، وتركيبًا بتركيب، والمعاني متقاربة، والألفاظ متشابهة، ويقع هذا في الأحاديث والخطب وسائر كلام الناس، إذ الرواية بالمعنى مألوفة غير مستنكرة، ولا سيما في الصدر الأول، بل اجترأ عليها في المتأخرين من لا يحسن سياسة القول فأساء.
فالحد الذي تنقطع عنده قدرة البشر إذًا هو هذا، وهو التفريق في كل حرف ولفظ وتركيب، حتى يقع كل ذلك في موقعه وسياقه، وحتى لا يجوز أن يبدل لفظ بلفظ، لأن كل شيء مقصود ملائم لموقعه الذي وقع فيه، وهو سياقه اللفظي في آياته وسورته، ثم المرتبة التي تعلو هذا مقامه وحاله ومعناه الذي يُستشهد به فيه على مر العصور، ومَنْزِله وموطنه الذي يُنَزَّل عليه باختلاف الدهور، ومسائله الكثيرة التي يحتج له به. ولا يعكر على هذا عجزنا عن تفسير كثير من المتشابه اللفظي في القرآن، لأنه قد فسَّر الناس بعضًا وعجزوا عن بعض، وأيقنوا بصحة ما فسروه من ذلك، فيجب أن يوقنوا بوجود الفرق والتفسير فيما عجزوا عنه، ويكلوا ذلك إلى عالمه ومنزله، وينتظروا به الأيام أن تكشفه، ذلك أن تأويله الكامل لا يعلمه إلا الله. ومن ههنا يظهر لك مزية الفروق كلها في (1) متن اللغة، (2) وفي علم المعاني وهو النظم، (3) وفي علم البيان، وهو التصوير، (4) وفي نظام السورة، (5) وفي نظام السور، علمنا من ذلك ما علمنا، وجهلنا ما جهلنا، ولا يجوز أن يحملنا جهلنا بالشيء على نفي وجوده، لأن القَدْر الذي علمناه منه دال عليه، مُطمع به.
(13) فهذا إذًا فيما نظن الوجه الباقي من إعجازه البياني، وهو الفروق في كل ناحية من نواحي اللسان والبيان، وهو ما يُعجز البلغاء والفصحاء، وأما الوجه الذي هو حظ العرب الذين سمعوه أول مرة فهو ما سلف من مباينته معهودهم في التعبير، مع موافقته طريقتهم في قوانين اللسان الظاهرة، وهو طبعه ومخرجه في تعبير الجاحظ. ولكن هذا معنى جزئي من معنى كلي في الإعجاز، أو في كينوته آية وبرهانًا على النبوة، ولا بد لنا من البحث عن هذا المعنى الكلي الذي يدخل فيه هذا المعنى الجزئي لبيان القرآن. ونحن إذا التمسنا معنى يتعلق بالقرآن وجب أن نلتمسه في القرآن نفسه، لا في شيء خارج عنه، إذ لا يتصور أن تكون دلالة القرآن على النبوة غير مدلول عليها في آياته، وقد تعود الناس على سرد آيات التحدي، وكثيرًا ما يغفلون عن آيات أوصاف القرآن في القرآن.
ولا أرى آية هي أدل على معنى الآية في القرآن، أي البرهان والحجة، أقرب من قوله تعالى: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)، فهذا وصف جامع للقرآن، فإذا ضممت إليه قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) كان المعنى الجامع لبرهانية القرآن، وعجز البشر أن يأتوا بمثله، هو حفظه من الباطل، والباطل ضد الحق، وهو ما لا حقيقة له، وما لا صحة له، ويعبَّر عنه بما لا ثبات له، تعبيرًا بما يئول إليه، ولذلك جاء النهي عن أكل المال بالباطل، أي أكله بما لا يصلح أن يكون سببًا، أي بلا شيء مكافئ. فهو في ثبوته كتابة وقراءة، وفي أخباره الماضية والمستقبلة، وفي أحكامه أمرًا ونهيًا، وفي مواعظه ترغيبًا وترهيبًا، خِلْوٌ من الباطل. ثم آيةُ سورة فصلت اشتملت على قسمين من وصف القرآن:
• أحدهما: الحفظ من الباطل من بين يديه ومن خلفه، أي لا يأتيه الباطل من شيء سبقه، ولا من شيء لحقه، فكل ما كان من علوم الناس في الماضي، وما يكون من علومهم في الآتي، لا ينقضه ولا يكذِّبه، ولا يبدي خللًا فيه أو نقصًا أو عيبًا. وبهذا يكون لكل صاحب علم في نوع من أنواع العلوم نصيب من الإعجاز. وهو معنى إنزاله بالحق. والحفظ من الباطل يشمل ثلاثة معانٍ: (1) الحفظ من التحريف والتبديل (2) والحفظ من الاختلاف (3) والحفظ من العوج.
(1) فالحفظ من التحريف والتبديل أن يبقى كما أنزله الله، بلا زيادة عليه، ولا نقصان منه، ولا إزالة لشيء عن موضعه أو وجهه، قليلًا أو كثيرًا، نطقًا أو رسمًا، وهو المتبادر من قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وسماه في هذا السياق ذكرًا، لأنه مذكِّر ومذَكَّر به، ومذكور ومذكور صاحبه.
(2) والحفظ من الاختلاف: هو ما ندعوه التناقض أو التعارض، فهو يفسر بعضه بعضًا، ويكمل بعضه بعضًا، ولا ينقض بعضه بعضًا، وهو ما قال الله فيه: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا).
(3) والحفظ من العوج: هو الحفظ من الميل الذاتي عن الاستقامة في كل أجزائه، فهو يجري على الإصابة والسداد في معانيه ومقاصده، فلا يبعد عن الحق ولا يميل، وهو القيم، أي المستقيم، أكد هذا المعنى بالنفي والإثبات في صدر سورة الكهف في سياق القصص: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا. قيمًا)، وبالنفي حَسْبُ في سورة الزمر في سياق الأمثال: (قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون).
• والمعنى الثاني مما في آية فصلت أنه عزيز، وعزته نفاسته، وغلبته وعلوه على غيره من الكلام، وامتناعه عن المجاراة أو المحاكاة، وهذا يشمل ثلاثة معان: (1) الحفظ من التفاوت (2) والحفظ من نفاد المعاني ومن البِلَى (3) والحفظ من الترادف والعبث والمصادفة.
(1) فالحفظ من التفاوت: هو ضرب من التشابه، لأن التشابه أنواع، فهو في طبقة واحدة من الإحكام والنسج، لا تضعف قطعة منه عن سائره.
(2) والحفظ من نفاد المعاني: هو وصفه بأنه مبارك، فلا يزال له إمداد وكشف في معانيه، لا يُشبَع منه، ولا تنقضي عجائبه، وقد كتب الناس في تفسيره وتدبره وعلومه ما لا حصر له، ولا يزال غضًّا طريًّا يطلب المزيد. ومثله حفظه من البِلَى فلا يُـمَلُّ منه، ولا يزهد فيه على التكرار، ولا يُزدرَى بالإعادة، بل حيثما تلي، أو سيق شيء منه في الاستشهاد، حلي في الفم والسمع والعين، وبان فضله، وتحقق أثره.
(3) والحفظ من الترادف والعبث والمصادفة: هو الحفظ من التكرار بلا طائل، ومن التشابه بلا فرق، بل كل ما تشابه منه بزيادة أو نقصان أو بدل أو تقديم أو تأخير، فلغرض ومعنى، ولملاءمة سياق ومقام، علمنا من ذلك ما علمنا، وجهلنا منه ما جهلنا. وهو نوع من الإحكام الموصوف به، ومن الحكمة الموصوف بها أيضًا.
فكل واحدة من هذه الوجوه لم تكن ولا تكون لشيء مما يقوله البشر أو يؤلفه البشر من الكلام والكتب، فكلها يعتريها التبديل والتعارض والعوج والتفاوت والنفاد والبلى والترادف ويأتيه الباطل، ويحتمل النقض، ويستولي عليه النقص، (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله).
والله أعلم
إسطنبول
23 من ذي القعدة 1443هـ
23 من حزيران 2022م |
|
| بارك الله فيك شيخنا الكريم وجزاك عنا كل خير |
|
| حفظ الله الشيخ محمد الزروق وجزاه الله عنا خيرا. |
|